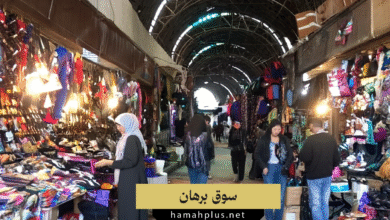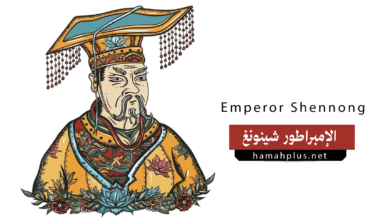النهضة التعليمية والثقافية في حماة: من الكتاتيب إلى المدارس الحديثة (1900-1946)
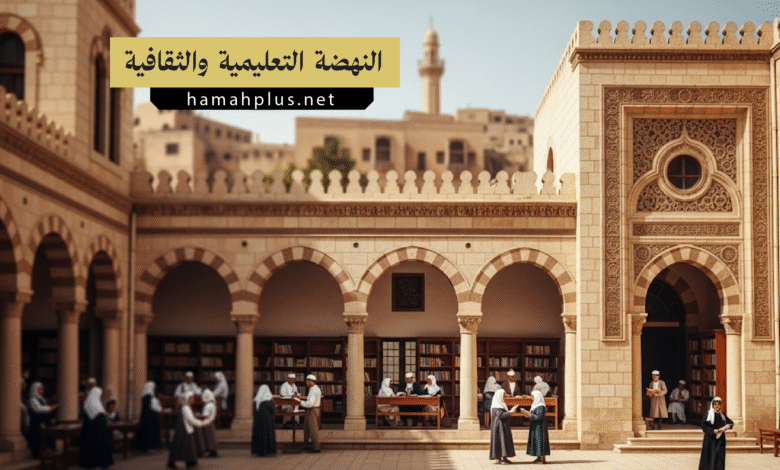
محتوى المقالة
المقدمة
لطالما كانت حماة، المدينة السورية العريقة، منارات للعلم والمعرفة عبر تاريخها الطويل، حيث كانت مركزاً مزدهراً لنسخ وبيع الكتب وخزائن العلم في العصر الأيوبي، مما يشير إلى إرث ثقافي عميق يمتد لقرون. هذه الخلفية التاريخية الغنية مهدت الطريق لتحولات عميقة في مطلع القرن العشرين. تمثل الفترة من 1900 إلى 1946 مرحلة مفصلية في تاريخ حماة، حيث شهدت المدينة انتقالاً جذرياً من أنماط التعليم التقليدية إلى تبني النظم التعليمية الحديثة، متأثرة بالتحولات السياسية والاجتماعية التي عصفت بالمنطقة، من أواخر العهد العثماني إلى فترة الانتداب الفرنسي وصولاً إلى فجر الاستقلال.
قبل هذه الحقبة، كانت الكتاتيب هي الركيزة الأساسية للتعليم، حيث تركز على تحفيظ القرآن الكريم ومبادئ القراءة والكتابة والخط. كانت هذه المؤسسات التقليدية تمثل النواة التي انطلقت منها بذور النهضة التعليمية. يستعرض هذا المقال التطور المتسارع للحركة التعليمية في حماة خلال هذه الفترة، ويسلط الضوء على دور الشخصيات والمؤسسات الرائدة التي ساهمت في نشر العلم والمعرفة، بالإضافة إلى تجليات النهضة الثقافية المصاحبة، مبيناً كيف شكلت هذه الحقبة ملامح التعليم الحديث في المدينة.
الفصل الأول: جذور التعليم في حماة: عصر الكتاتيب وما قبله
لطالما كان التعليم التقليدي في حماة، كما هو الحال في معظم المدن العربية، متجذراً في نظام الكتاتيب والمساجد، الذي شكل العمود الفقري للمعرفة قبل ظهور المدارس الحديثة.
وصف تفصيلي لنظام الكتاتيب في حماة
كانت الكتاتيب تمثل البيئة التعليمية الأولى للأطفال في حماة. كانت غرفة الكتاب عبارة عن حجرة كبيرة المساحة، تتسع لجلوس حوالي خمسين تلميذاً يجلسون على حصيرة على الأرض أمام الشيخ. يجلس الشيخ بدوره على دكة خشبية مرتفعة قليلاً تعلوها جلد خروف، وأمامه منضدة قليلة الارتفاع عليها أدوات الكتابة، وخلفه سبورة سوداء على الحائط.
تركز المنهج في الكتاتيب على أصول الكتابة والخط الجيد، والقراءة، وحفظ آيات القرآن الكريم، بالإضافة إلى بعض مبادئ العمليات الحسابية الأربعة. كان التعليم يعتمد بشكل كبير على الاستظهار والحفظ، وهو نمط تقليدي كان سائداً في تلك الفترة. كان الشيخ، أو المعلم، يتمتع بمكانة مرموقة واحترام وتبجيل لدى العامة، حيث كانت وظيفته حينذاك مقتصرة على الأمور الدينية ودروس المساجد وتعليم الصغار. كان يبذل أقصى جهده لتعليم الجميع، كل حسب مستواه وقدرته على الاستيعاب.
أما عن التمويل والموارد، فقد كان نظام الكتاتيب يعتمد بشكل كبير على مساهمات الطلاب وأهاليهم. كان التلاميذ يقدمون ما يسمى “الخميسية” لشيخهم كل يوم خميس، وهي عبارة عن كمية من الحبوب أو الزبيب أو البيض أو الجوز. وفي فصل الشتاء، كان على التلميذ أن يأتي كل يوم ومعه قطعة من الحطب لإيقادها في مدفأة الكتاب لتدفئة الجميع، وما يزيد يذهب لتدفئة منزل الشيخ. كان الشيخ يتلقى أجوره من أهالي التلاميذ بعد جني المحاصيل الزراعية من مواد عينية مثل الحنطة أو البطاطا أو الزبيب أو البقوليات أو الدبس، وكان الأهالي يقدمون ذلك عن طيب خاطر تقديراً لجهده الكبير في تعليم أبنائهم.
لم تخلُ قاعات الدرس من وسائل الانضباط الصارمة؛ فكانت تحتوي على عصا طويلة من نبات القصب ليطال بها الشيخ أبعد التلاميذ، بالإضافة إلى ملزمة خشبية لمعاقبة التلميذ المشاغب أو المقصر في الحفظ أو كتابة الواجبات، حيث يشد بها أيدي التلميذ أو يرفعه “فلقة” على القدمين بمساعدة تلميذ كبير. وعندما يتقن التلميذ القراءة والكتابة والخط الجيد وحفظ القرآن، أي ينهي تعليمه، كان يُجرى له احتفال تخرج من الكتاب يُدعى “الختمية”، وهو حدث اجتماعي وثقافي مهم يبرز إنجاز الطالب.
التعليم الديني والمساجد كركائز للمعرفة
في العصور الإسلامية، حلت المساجد محل المعابد والكنائس كمؤسسات تعليمية رئيسية. في حماة، كانت المساجد الكبرى مثل الجامع الأعلى (الجامع الكبير) والجامع الأسفل (جامع النوري) مفتوحة لحلقات العلم المتنوعة، بالإضافة إلى ما ألحق بالمدارس كجامع المدرسة العصرونية. كانت هذه المساجد مراكز للإشعاع العلمي والفكري، حيث يقصدها طلاب العلم من جميع المدن والأقطار الإسلامية.
لمحة عن الوضع التعليمي في حماة أواخر العهد العثماني (قبل 1900)
في عام 1885م، كان في لواء حماة 22 مدرسة ابتدائية ضمت 1250 تلميذاً، ومدرسة رشدية واحدة ضمت 40 تلميذاً. تشير هذه الأرقام إلى أن معظم مدارس حماة كانت لا تزال كتاتيب صغيرة، مع بداية ظهور المدارس النظامية الحديثة.
الجدير بالذكر أن بذور التعليم الحديث كانت موجودة وتنمو تدريجياً قبل بداية الفترة المحددة في هذا البحث (1900-1946). فقد تأسس مكتب الرشدية للبنين في حماة حوالي عام 1287 هـ (1870-1871م)، وقد أرخ شعراء حماة هذا الحدث، مما يدل على أن حماة كانت سباقة في تبني التعليم الحديث قبل بداية القرن العشرين. هذا يضع الفترة 1900-1946 في سياقها الصحيح كفترة تسارع وتوسع للتحول، وليس مجرد نقطة بداية. كما يبرز مرونة المجتمع الحموي في استيعاب التغيير والتأثر بالتوجهات العثمانية نحو التحديث.
أما فيما يتعلق بالتمويل، فقد شهدت هذه الفترة تحولاً في نموذج الدعم التعليمي. فبينما كانت الكتاتيب تعتمد بشكل كامل على مساهمات الطلاب العينية والأجور العينية من الأهالي ، بدأت المدارس الحديثة (مثل الرشدية) تكون جزءاً من نظام تعليمي حكومي عثماني. هذا التحول في نموذج التمويل من الاعتماد الكلي على المجتمع المحلي إلى دور متزايد للدولة يعكس مركزية التعليم وتزايد تكلفته وتعقيده. كما يشير إلى أن التعليم بدأ ينتقل من كونه خدمة مجتمعية محلية إلى مؤسسة منظمة تتطلب دعماً أكبر من السلطات المركزية.
الفصل الثاني: فجر المدارس الحديثة: التحول في مطلع القرن العشرين (1900-1920)
شهد مطلع القرن العشرين تحولاً جذرياً في المشهد التعليمي بمدينة حماة، حيث بدأت المدارس الحديثة، التي تعتمد على مناهج منظمة وأنظمة إدارية متطورة، تحل تدريجياً محل الكتاتيب التقليدية.
تأسيس المدارس الرشدية في حماة
كانت المدارس الرشدية أولى المدارس النظامية الحديثة التي ظهرت في حماة. كما ذكرنا سابقاً، تأسس مكتب الرشدية للبنين في حماة حوالي عام 1287 هـ (1870-1871م)، وقد أرخ شعراء حماة هذا الحدث، مثل الشاعر العلامة أسعد بن أحمد العظم الحموي، والعلامة المؤرخ نوري باشا الكيلاني الذي امتدح السلطان عبد الحميد الثاني على إحسانه بتأسيس هذه المدرسة، مما يؤكد على أن حماة كانت سباقة في تبني التعليم الحديث.
إلى جانب مدارس البنين، شهدت حماة تأسيس المدرسة الرشدية للإناث عام 1911م، وهو تطور مهم يعكس توسع التعليم ليشمل الفتيات. ضمت هذه المدرسة 6 صفوف على مرحلتين دراسيتين: صفي رشدية (إعدادي) و4 صفوف ابتدائية مع صف الاحتياط.
المناهج والمواد الدراسية في المدارس الرشدية (مقارنة بالكتاتيب)
توسعت المناهج في المدارس الرشدية بشكل كبير لتتجاوز مجرد حفظ القرآن والكتابة، مقدمة تعليماً أكثر شمولاً وتنوعاً. ففي المدرسة الرشدية للإناث عام 1913، شملت المواد القرآن الكريم والتجويد، الجغرافيا، تاريخ الإسلام، الصرف العثماني (التركي)، تعاليم الإسلام باللغتين التركية والعربية، الخياطة (للمبتدئين)، القراءة الأخلاقية، التعاليم الوطنية، الحساب، الإملاء التركي والعربي، المشغولات اليدوية، وحسن الخط. هذا التوسع في المواد الدراسية يمثل نقلة نوعية عن المنهج المحدود في الكتاتيب، ويوفر للطلاب قاعدة معرفية أوسع.
تضمنت المناهج في المدرسة الرشدية للإناث عام 1913 مواد مثل “تعاليم الإسلام باللغة التركية” و”تعاليم الإسلام باللغة العربية”، بالإضافة إلى “الإملاء التركي” و”الإملاء العربي”. هذا يعكس محاولة الدولة العثمانية لدمج لغتها وثقافتها مع الحفاظ على جزء من الهوية المحلية، ولكنه أيضاً يمثل تحدياً للهوية التعليمية الناشئة في المنطقة العربية. هذه الازدواجية في المناهج تشير إلى فترة انتقالية معقدة، حيث كانت الدولة العثمانية تسعى لتحديث التعليم وتوحيده تحت مظلتها، لكنها لم تستطع تجاهل اللغة والثقافة العربية بالكامل. هذا التوازن الدقيق يعكس التوترات الكامنة بين المركز العثماني والأطراف العربية، ويظهر أن التعليم كان ساحة للتعبير عن هذه التوترات الثقافية والسياسية.
كما أن وجود مادة “التعاليم الوطنية” في منهج المدرسة الرشدية للإناث عام 1913 يدل على وعي مبكر بأهمية غرس الحس الوطني، حتى في ظل الحكم العثماني الذي كان يواجه تحديات قومية متزايدة. هذا يشير إلى أن بذور الوعي القومي كانت تتشكل قبل فترة الانتداب، وأن التعليم كان يُنظر إليه كأداة لبناء الهوية، ليس فقط الدينية أو الإقليمية، بل الوطنية أيضاً. هذا يعزز فكرة أن النهضة التعليمية كانت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالتحولات السياسية والفكرية الأوسع في المنطقة.
دور الدولة العثمانية في إرساء التعليم النظامي
كانت المدارس الرشدية جزءاً من سياسة تعليمية أوسع للسلطان عبد الحميد الثاني، الذي شهد عهده ارتفاعاً ملحوظاً في عدد المدارس الابتدائية والإعدادية ودور المعلمين في جميع أنحاء الدولة العثمانية. هذا يؤكد على أن التحديث التعليمي لم يكن مقتصراً على حماة بل كان جزءاً من رؤية إمبراطورية. هذا يوضح أن التحول التعليمي في حماة لم يكن معزولاً، بل كان جزءاً من توجه إمبراطوري أوسع، مما يفسر التشابه في المناهج والأسماء (الرشدية) عبر مدن الإمبراطورية.
ظهور المدارس الخاصة والأهلية الأولى
إلى جانب المدارس الحكومية العثمانية، بدأت بعض المدارس الأهلية بالظهور في سوريا بدافع الغيرة على مستقبل اللغة العربية والقومية العربية، كاستجابة للسياسات العثمانية التي فرضت اللغة التركية. في حماة، بدأت تظهر مدارس خاصة مثل مدرسة عنوان النجاح التي أسسها مفتي حماة الشيخ سعيد النعسان ، مما يدل على مبادرات محلية قوية لدعم التعليم العربي. هذا يبرز دور المجتمع المحلي في الحفاظ على هويته الثقافية واللغوية في وجه سياسات التتريك.
الفصل الثالث: التعليم في حماة تحت الانتداب الفرنسي (1920-1946): تحديات وتوسع
مع بداية فترة الانتداب الفرنسي على سوريا ولبنان عام 1920، دخل التعليم في حماة مرحلة جديدة اتسمت بتحديات فرض الهيمنة الأجنبية وتوسع نطاق التعليم بمبادرات وطنية ومحلية.
سياسات الانتداب التعليمية وتأثيرها على حماة
لم تكن السياسة الثقافية والتعليمية للمفوضية السامية الفرنسية هدفاً بحد ذاته، بل كانت وسيلة لتعزيز النفوذ الاستعماري الفرنسي في المشرق. تنازع اتجاهان السياسة التعليمية الفرنسية في المشرق: “السياسة الفرنسية الصغيرة” التي قامت على محاباة أبناء الأقليات واعتبارهم نقاط ارتكاز للهيمنة، و”السياسة الفرنسية الكبيرة” التي دعت للاستناد على أبناء الأكثرية ليكونوا رابطاً أكثر فاعلية.
سعى الانتداب لتدعيم تواجده بالسيطرة على شبكة المدارس العامة والخاصة، خاصة بتقديم المعونات للمدارس الخاصة الكاثوليكية مثل المدرسة اللعازرية. هذه المدارس كانت تدرس بالفرنسية بالكامل، مما عكس رفضاً للغة العربية كهوية وطنية. صدمت طريقة التعليم في هذه المدارس الشعور الوطني لدى السوريين، مما أدى إلى حملات احتجاج منتظمة في الصحافة الدمشقية ضد مناهج وكتب التدريس التبشيرية.
بالرغم من هذا، استمر الوجهاء المسلمون في سوريا، بمن فيهم نخب دمشق وحلب من الضباط وكبار الإداريين والتجار والوزراء والحكام، في إرسال أولادهم لتعلم الفرنسية في مدارس الإرساليات، بالرغم من الحذر تجاه التعليم العلماني. هذا يعكس واقعاً معقداً حيث كانت الفرص التعليمية المتقدمة مرتبطة بإتقان اللغة الفرنسية، مما دفع النخب للاستفادة منها رغم التحفظات الوطنية.
عمل الانتداب أيضاً على التغلغل في المؤسسات المحلية من خلال إعداد النخب العلمية والتقنية التي درست في مؤسسات التعليم الغربية في المنطقة أو في الجامعات والمعاهد الغربية. في المقابل، نشأت الجامعة السورية التي كانت نواتها الأصلية أيام العثمانيين عام 1903 كمكتب طبي في دمشق، وتأسست الجامعة السورية رسمياً في 15 حزيران 1923، واحتفظت بطابعها العربي في إدارتها ومسيرتها. تم جمع التبرعات المحلية عام 1923 لدعم إقامتها، مما يؤكد على الإرادة الوطنية في الحفاظ على التعليم العربي.
تطور أعداد المدارس والطلاب خلال هذه الفترة
شهدت سوريا بشكل عام، وبالتالي حماة، تضاعفاً في عدد المدارس وطلابها تقريباً خلال الفترة 1924-1938، من 1590 مدرسة إلى 2554 مدرسة، وعدد تلامذتها من 126,000 إلى 280,000 تلميذاً. من هؤلاء، 92,000 تلميذاً فقط كانوا يدرسون في المدارس الحكومية، و55,000 في المدارس الفرنسية “شبه الرسمية” التي كانت تحصل على معونات مكثفة من المفوضية السامية، بينما بلغ عدد تلاميذ المدارس الخاصة (الإسلامية والمسيحية) 120,000 تلميذاً. هذه الأرقام تظهر توسعاً كبيراً في التعليم، ولكنه يكشف أيضاً عن تنوع في أنواع المدارس والجهات الممولة لها.
المناهج الدراسية: التوازن بين الهوية الوطنية والتأثير الغربي
سعت السلطات الوطنية إلى فرض رؤيتها التعليمية بالتوازي مع سياسات الانتداب. نصت المادة 20 من قانون التعليم على أن يكون أساس التربية والتعليم والخصوصية واحدة على أساس المبادئ الوطنية في جميع المقاطعات السورية. كما نصت المادة 21 على أن يكون التعليم الابتدائي إجبارياً وفي المدارس الرسمية مجاناً ، بينما نصت المادة 22 على أن تأسيس المدارس الخصوصية حر ضمن قانونها الخاص.
في عام 1921، أذاعت مديرية المعارف العامة بلاغاً بوجوب تعليم الطلاب 600 كلمة عربية فصحى مقابل 600 كلمة عامية سنوياً وإجبارهم على استعمالها، في محاولة لتعزيز اللغة العربية الفصحى. وفي عام 1938، أصدر الرئيس هاشم الأتاسي مرسوماً يحدد اللغات الأجنبية المطلوبة في البكالوريا، والتي شملت الإنكليزية، الألمانية، الإيطالية، الإسبانية، والروسية. هذا يعكس محاولة لمواكبة التطورات العالمية مع الحفاظ على الهوية اللغوية.
أمثلة على المدارس البارزة في حماة خلال هذه الفترة
شهدت حماة خلال فترة الانتداب ظهور وتطور العديد من المدارس الهامة:
- مدرسة عنوان النجاح: أسسها مفتي حماة الشيخ سعيد النعسان ، وأصبح الشيخ محمود الشقفة مديراً لها عام 1928.
- مدرسة دار العلم والتربية: تعلم فيها أكرم الحوراني، وقد أسسها الملك فيصل الأول بن الحسين قرب قصر العظم في حماة.
- مدرسة ملجأ الأيتام: في عام 1936، تمكنت الجمعية الإسلامية لرعاية الأيتام من الانتفاع بخان رستم باشا الذي ضم مدرسة ابتدائية ومهاجع للأيتام. بلغ عدد الأيتام 35 في عام 1940 وارتفع إلى 75-80 في عام 1944. كان للمدرسة فرقة موسيقية عام 1946.
- مدرسة السيدة عائشة: كانت مدرسة حكومية موجودة بحماة بحلول عام 1925.
- مدرسة البنات للروم الأرثوذوكس: كانت موجودة في حماة عام 1927.
هذه الأمثلة تبرز التنوع في المبادرات التعليمية، من مدارس أهلية ذات طابع ديني ووطني إلى مدارس حكومية وأخرى تابعة للأقليات.
كان التعليم في هذه الفترة أداة للهيمنة والمقاومة في آن واحد. استخدم الانتداب الفرنسي التعليم لتعزيز نفوذه ، من خلال دعم المدارس التبشيرية التي ركزت على اللغة الفرنسية، مما أدى إلى “صدمة الشعور الوطني” وحملات احتجاج في الصحافة الدمشقية. في المقابل، سعت السلطات الوطنية لتعزيز اللغة العربية ، والجامعة السورية حافظت على طابعها العربي ، مما يعكس مقاومة ثقافية قوية. هذا التوتر بين الأهداف الاستعمارية والأهداف الوطنية في المجال التعليمي يظهر كيف أن التعليم لم يكن مجرد عملية أكاديمية، بل ساحة صراع على الهوية الثقافية والسياسية. هذا الصراع أثر على المناهج واللغات المستخدمة، وشكل وعي الأجيال المتعاقبة.
كما أن الفجوة الاجتماعية في التعليم كانت واضحة. فأقساط مدارس البعثة الفرنسية كانت مرتفعة، مما جعلها في متناول الطبقتين الوسطى والميسورة فقط، وقلة من العائلات المسلمة كانت ترسل أبناءها إليها. هذا يتناقض مع نص المادة 21 من قانون التعليم الذي جعل التعليم الابتدائي إجبارياً ومجانياً في المدارس الرسمية. هذا يشير إلى أن النهضة التعليمية، رغم توسعها، لم تكن متساوية في الوصول إليها، مما أدى إلى تباينات طبقية ومذهبية في الفرص التعليمية. هذا التفاوت قد يكون ساهم في “اغتراب” بين أبناء الشعب الواحد، حيث نشأت نخب متعلمة في المدارس الأجنبية ونخب أخرى في المدارس الوطنية أو الرسمية، مما أثر على التماسك الاجتماعي والثقافي في المدينة.
الفصل الرابع: رواد النهضة: شخصيات ومؤسسات صنعت التغيير
لم تكن النهضة التعليمية والثقافية في حماة مجرد تطور تلقائي، بل كانت ثمرة جهود حثيثة لشخصيات قيادية ومؤسسات رائدة آمنت بأهمية العلم ودوره في بناء المجتمع.
الشخصيات الرائدة
برزت عدة شخصيات كان لها دور محوري في قيادة دفة التعليم في حماة خلال هذه الفترة:
- الشيخ سعيد النعسان (1867-1967م): كان مفتي حماة ورائد نهضتها، ومعلماً للأجيال. تولى منصب مدير المعارف حتى عام 1921م، ثم عين مفتياً عاماً على حماة وضواحيها من عام 1925م حتى وفاته. كان أيضاً رئيساً لمجلس أوقاف حماة وعضواً في المجلس الإسلامي الأعلى. أسس مدرسة عنوان النجاح، التي أصبحت منارة للعلم في المدينة. لعب دوراً وطنياً في التحريض ضد الفرنسيين واستضاف علماء دمشق الذين كانوا يجوبون المدن السورية لإثارة الثورة ضد الاستعمار. كرم عام 1957 لجهوده في النهضة العلمية والفكرية والاجتماعية والجهادية، مما يؤكد مكانته كرمز للنهضة في حماة.
- الشيخ محمود الشقفة (1883-1961م): تخرج من مدرسة سلطاني التجهيز. برع في علوم الفقه واللغة والأدب، وكان يحفظ أشعار العرب وخطبهم. عمل مدرساً في مدرسة عنوان النجاح ثم مديراً لها عام 1928. كان له نشاط ملحوظ في التعليم والدعوة في حماة وريفها، وولي منصب الإفتاء في سلمية.
- محمد الحسن الحموي (1877-1935م): عالم مسلم ومتصوف وكاتب وشاعر. ولد في حماة وتعلم في الأزهر. أسس في حماة مدرسة سماها “الكلية الإسلامية الحرة”، مما يدل على مبادرته في إرساء تعليم حديث ذي طابع إسلامي. عمل لاحقاً مديراً لمدرسة أهلية وأميناً لمكتبة.
- أكرم الحوراني (1911-1996م): شخصية سياسية سورية بارزة من حماة. تعلم في مدرسة دار العلم والتربية التي أسسها الملك فيصل الأول بن الحسين قرب قصر العظم. يمثل الحوراني نموذجاً للجيل الذي تلقى تعليماً حديثاً وأصبح له دور قيادي في الحياة السياسية لاحقاً.
المؤسسات الرائدة
لعبت المؤسسات التعليمية دوراً لا يقل أهمية عن الشخصيات في دفع عجلة النهضة:
- المدرسة الرشدية (بنين وبنات): كانت نموذجاً للتعليم الحديث الذي أدخلته الدولة العثمانية، ثم استمر وتطور في عهد الانتداب. قدمت منهجاً يمزج بين العلوم التقليدية والحديثة، وساهمت في تخريج أجيال متعلمة.
- المدارس الأهلية والخيرية: مثل مدرسة عنوان النجاح ، ومدرسة دار العلم والتربية ، ومدرسة ملجأ الأيتام ، ومدرسة السيدة عائشة. هذه المدارس لعبت دوراً حيوياً في توسيع قاعدة التعليم وتلبية احتياجات المجتمع، غالباً بمبادرات محلية ووطنية، مما يعكس حيوية المجتمع المدني في حماة.
دور العائلات الحموية في دعم الحركة التعليمية والثقافية
كان للعائلات الحموية التقليدية، مثل آل العظم وآل الكيلاني، نفوذ قوي في المدينة. أسعد بن أحمد العظم الحموي ونوري باشا الكيلاني أرخوا لتأسيس مكتب الرشدية، مما يدل على اهتمامهم بالتعليم الحديث. كما أن الملك فيصل الأول أسس مدرسة دار العلم والتربية قرب قصر العظم. هذه العائلات لعبت دوراً محورياً في دعم الحركات الوطنية والتعليم، مما يبرز تداخل الأدوار بين النخب التقليدية والتوجهات الحديثة.
يتضح أن النهضة التعليمية في حماة لم تكن حكراً على جهة واحدة، بل كانت جهداً مجتمعياً متكاملاً. فالعلماء (مثل النعسان والشقفة والحموي) كانوا قادة فكريين ومؤسسي مدارس، بينما الوجهاء والعائلات الكبيرة (مثل العظم والكيلاني) قدموا الدعم المادي والسياسي، وبعضهم كان مرتبطاً بتأسيس مدارس. هذا التضافر بين السلطة الدينية والفكرية والنفوذ الاجتماعي والاقتصادي كان حاسماً لنجاح مشاريع النهضة التعليمية. هذا يدل على طبيعة مجتمعية شاملة للتحول، حيث لم تكن النخب التقليدية عائقاً أمام التحديث، بل أصبحت جزءاً فاعلاً فيه، مما منح هذه النهضة قوة دفع محلية وأصالة.
علاوة على ذلك، أصبحت هذه المدارس الجديدة حاضنات لتكوين النخب الوطنية التي ستقود البلاد لاحقاً. فشخصيات مثل أكرم الحوراني، الذي أصبح سياسياً بارزاً، تلقى تعليمه في هذه المدارس الحديثة. هذا يربط التعليم بالبناء السياسي والوطني، مبيناً كيف أن الاستثمار في المعرفة كان استثماراً في مستقبل القيادة الوطنية، وأن هذه المدارس ساهمت في تشكيل الوعي السياسي والاجتماعي لدى الأجيال الصاعدة.
الفصل الخامس: تجليات النهضة الثقافية: الأدب والفنون والمجتمع
إلى جانب التطور التعليمي الملحوظ، شهدت حماة خلال الفترة (1900-1946) تجليات لنهضة ثقافية أوسع، وإن كانت بعض جوانبها لم توثق بشكل مفصل في المصادر المتاحة.
تطور المكتبات ودورها في إثراء الحياة الفكرية
على الرغم من أن حماة كانت تاريخياً مركزاً لنسخ وبيع الكتب وخزائنها في العصر الأيوبي، وكانت أسواقها تحتوي على العديد من الحوانيت المخصصة لبيع الكتب ونسخها، كما ضمت العديد من خزائن الكتب الخاصة والعامة ، إلا أن المصادر المتاحة لا تقدم تفاصيل محددة عن تطور المكتبات العامة أو الخاصة البارزة في حماة خلال الفترة 1900-1946. هذا قد يشير إلى أن التطور الثقافي في هذا الجانب لم يكن بارزاً بنفس القدر مقارنة بالتعليم الرسمي، أو أن التوثيق التاريخي لهذه المؤسسات أقل شيوعاً. من الممكن أن تكون النهضة التعليمية قد حفزت القراءة الفردية واقتناء الكتب الخاصة أكثر من إنشاء مؤسسات مكتبية كبرى في تلك الفترة، أو أن هذه المؤسسات كانت موجودة ولكن لم يتم توثيقها بشكل كافٍ في المصادر المتاحة.
الصحافة في حماة
المصادر المتاحة تشير إلى وجود صحف سورية عامة في أوائل القرن العشرين ، لكنها لا تقدم معلومات محددة عن صحف أو مطابع خاصة بحماة خلال الفترة المحددة. المطبعة المارونية في حلب كانت تزود مطابع سوريا ولبنان بالحروف، مما يشير إلى مركزية حلب وبيروت في هذا المجال. نظراً لعدم وجود بيانات مباشرة عن صحافة أو مطابع في حماة خلال الفترة المحددة، يمكن الاستنتاج أن حماة ربما كانت تعتمد على مراكز الطباعة والنشر الأكبر في سوريا (كحلب ودمشق) أو بيروت، وأن التأثير الثقافي للصحافة كان يأتي من هذه المراكز. هذا يعكس تراتبية في التطور الثقافي بين المدن السورية، حيث كانت بعض المدن مراكز إشعاع ثقافي أكبر في مجالات معينة، بينما استفادت حماة من هذا الإشعاع بشكل غير مباشر.
تأثير النهضة التعليمية على الحركة الأدبية والفنية في المدينة
نشأت الحركة الفنية الحديثة في سوريا في عشرينيات القرن العشرين في دمشق وحلب، ثم لاحقاً في حمص وحماة. ومع ذلك، لا تذكر المصادر فنانين محددين من حماة أو حركات فنية مرتبطة بالتعليم فيها بشكل مباشر خلال هذه الفترة.
ومع ذلك، يمكن ملاحظة بعض المظاهر الثقافية الأوسع التي تعكس وعياً متزايداً بالهوية المحلية والوطنية. على سبيل المثال، صدرت طوابع بريدية تحمل صوراً لمعالم حماة، مثل طابع حي الكيلانية، وطابع بانوراما الجامع الأعلى الكبير، وطابع جامع العجمي، وجامع النوري ونواعير الصهيونية والبشريات، وذلك من عام 1925 وما بعده. هذه الطوابع، وإن لم تكن مرتبطة مباشرة بمؤسسات تعليمية أو حركات فنية، فإنها تمثل شكلاً من أشكال التعبير الثقافي وتخليد التراث المحلي، مما يشير إلى تقدير متزايد للهوية البصرية للمدينة.
بينما قد تكون الروابط المباشرة بين التعليم والحركة الأدبية والفنية في حماة غير مفصلة في المصادر المتاحة، فإن توسع التعليم الحديث، وخاصة إدخال “التعاليم الوطنية” والتركيز على اللغة العربية ، قد أسهم بشكل لا يمكن إنكاره في بناء مجتمع أكثر وعياً وثقافة. هذا الوعي المتزايد ساهم في تعزيز دور حماة كمركز للمقاومة الوطنية ضد الانتداب الفرنسي. هذا الارتباط بين التطور التعليمي والوعي الاجتماعي والسياسي يضع التعليم ليس فقط كمسعى أكاديمي، بل كمحفز للنهضة الوطنية والهوية الثقافية. التأثير الثقافي يمتد بذلك إلى تحول أعمق في الوعي المجتمعي والمشاركة السياسية، حتى لو لم يتجسد بالضرورة في إنتاج فني أو أدبي محدد وموثق بشكل كبير.
الخلاصة
لقد شهدت حماة خلال الفترة من 1900 إلى 1946 تحولاً عميقاً في بنيتها التعليمية والثقافية، متجاوزةً الأنماط التقليدية للكتاتيب نحو نظام تعليمي حديث ومتنوع. لم تكن هذه النهضة قفزة مفاجئة، بل استمراراً لتطور بدأ في أواخر العهد العثماني، حيث ظهرت المدارس الرشدية كبذرة للتعليم النظامي قبل بداية القرن العشرين.
لقد لعبت الشخصيات المحلية البارزة، من علماء ووجهاء، دوراً محورياً في قيادة هذا التحول. فمن أمثال الشيخ سعيد النعسان والشيخ محمود الشقفة ومحمد الحسن الحموي، الذين أسسوا وأداروا المدارس، إلى العائلات الكبيرة مثل آل العظم وآل الكيلاني التي قدمت الدعم والمبادرات، تضافرت الجهود المجتمعية مع التوجهات الحكومية لإنشاء بنية تعليمية جديدة. المدارس الرشدية، والمدارس الأهلية والخيرية مثل مدرسة عنوان النجاح ودار العلم والتربية وملجأ الأيتام، كلها ساهمت في توسيع قاعدة التعليم وتقديم مناهج أكثر شمولاً، مزجت بين العلوم التقليدية والحديثة، وأدخلت مفاهيم مثل “التعاليم الوطنية”.
تأثرت هذه النهضة التعليمية بشكل كبير بالسياق السياسي والتاريخي للمنطقة. ففي ظل الحكم العثماني، عكست المناهج المزدوجة (التركية والعربية) محاولة الدولة لفرض هيمنتها الثقافية مع الحفاظ على جزء من الهوية المحلية. وخلال فترة الانتداب الفرنسي، أصبح التعليم ساحة صراع بين الأهداف الاستعمارية الفرنسية (التي سعت لتعزيز نفوذها عبر المدارس التبشيرية) والإرادة الوطنية السورية في الحفاظ على اللغة العربية والهوية الثقافية. هذا التوتر، وإن أدى إلى تباينات اجتماعية في الوصول إلى التعليم، إلا أنه حفز أيضاً الوعي الوطني وساهم في تشكيل جيل من القادة السياسيين والمثقفين.
على الصعيد الثقافي الأوسع، ورغم أن المصادر لا تفصل بشكل كبير في تطور المكتبات أو الصحافة أو الحركات الفنية المحلية في حماة خلال هذه الفترة، إلا أن النهضة التعليمية أسست لوعي ثقافي عام، وعززت الهوية الوطنية، وساهمت في ترسيخ مكانة حماة كمركز حضاري عريق. لقد وضعت هذه الحقبة الأسس لمستقبل التعليم والثقافة في حماة، ممهدة الطريق لتطورات لاحقة بعد الاستقلال، ومؤكدة على الدور الحيوي للمدينة في المشهد السوري الأوسع.