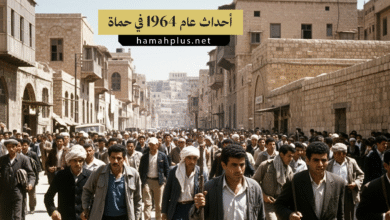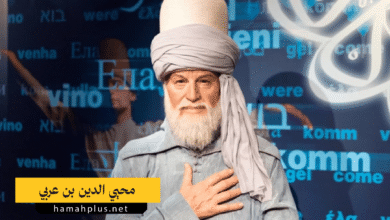حماة في العصر الأموي: دراسة تاريخية شاملة

جدول المحتويات
حماة في العصر الأموي
تُعد مدينة حماة، المعروفة بـ”أم النواعير”، من المدن السورية العريقة التي تحمل في طياتها تاريخاً غنياً يمتد لآلاف السنين. تقع حماة في الجزء الغربي من بلاد الشام، وتتميز بموقعها الفريد على نهر العاصي الذي يقسمها إلى شقين، الشرقي المعروف بـ”الحاضر” والغربي بـ”السوق”. وقد اشتهرت المدينة بنظامها المائي المبتكر المتمثل في النواعير، التي كانت تُستخدم لسقاية البيوت والبساتين والمساجد، مما يعكس اعتمادها العميق على الموارد المائية في حياتها اليومية والاقتصادية.
تعود جذور حماة إلى عصور ما قبل التاريخ، حيث دخلت تحت سيطرة النبي داود عليه السلام حوالي عام 1000 قبل الميلاد، وكانت تُعرف آنذاك بمملكة صوبة، وتُصنف ضمن أكبر المدن في المنطقة في ذلك الحين. كما ارتبطت بلاد الشام عموماً بأسماء تاريخية عديدة مثل بلاد آرام وأرض كنعان وفينيقيا، مما يؤكد عمقها الحضاري وتراثها المتجذر. اقتصادياً، اشتهرت حماة قبل الفتح الإسلامي بزراعة أشجار الزيتون واستثمارها بشكل كبير، وتُشير الآثار في قراها إلى وجود العديد من مطاحن الزيت ومخازنه، ما يؤكد أهمية هذه الصناعة في المنطقة.
وقد بُني سور المدينة الكبير في فترات مبكرة تعود إلى عهد الإمبراطور أنستاسيوس الأول (491-518م) أو الإمبراطور جوستنيانوس الأول (527-529م)، مما يشير إلى أهميتها الدفاعية والاستراتيجية عبر العصور. إن التباين بين الأهمية التاريخية والجغرافية والاقتصادية لحماة قبل العصر الأموي، وما شهدته المدينة من تراجع عمراني خلال هذا العصر، يشير إلى علاقة معقدة بين حماة في العصر الأموي والسلطة الأموية المركزية. هذا التباين يتطلب فهماً دقيقاً لكيفية تأثير السياسات المركزية والعوامل المحلية على تطور المدن الثانوية ضمن الإمبراطورية. تأسست الدولة الأموية كخلافة إسلامية كبرى، وهي الثانية في تاريخ الإسلام، على يد معاوية بن أبي سفيان عام 661 م، بعد انتصاره في الفتنة الأولى. اتخذ الأمويون من دمشق عاصمة لخلافتهم، لتصبح بلاد الشام بمثابة القلب النابض للدولة ومصدر قوتها العسكرية.
لقد شكل الجيش الشامي أساس قوة الأمويين، مما مكنهم من بسط نفوذهم على الولايات المفتوحة. في أوج اتساعها، امتدت الخلافة الأموية (661-750 م) على مساحة شاسعة من إفريقيا والأندلس غرباً إلى خراسان والسند شرقاً، لتصبح واحدة من أكبر الإمبراطوريات في التاريخ.
تهدف هذه المقالة إلى تقديم دراسة شاملة لمدينة حماة خلال العصر الأموي (661-750 م)، مع التركيز على مكانتها الإدارية، جوانب حياتها الاقتصادية، مظاهرها الاجتماعية والثقافية، وتطورها العمراني، وذلك بالاستناد إلى المصادر التاريخية المتاحة التي تتناول حماة في العصر الأموي. سنكتشف كيف أن حماة في العصر الأموي كانت جزءًا من جند حمص ضمن الأجناد الشامية، وكيف أثرت هذه التبعية الإدارية على تطورها. كما سنسلط الضوء على الأهمية الزراعية لمدينة حماة في العصر الأموي، ودور النواعير ونهر العاصي في دعم اقتصادها.
ولا يغفل البحث الجوانب الاجتماعية والثقافية، بما في ذلك التركيبة السكانية وتأثير القبائل على عمران حماة في العصر الأموي، مع إبراز أي إشارات إلى الحركة العلمية فيها. علاوة على ذلك، سنحلل حالة العمران في حماة في العصر الأموي ومقارنتها بحركة البناء الأموية في دمشق، مع التطرق إلى التحديات والأحداث البارزة التي مرت بها حماة في العصر الأموي. هذه الدراسة ستسعى لتقديم صورة متكاملة عن وضع حماة في العصر الأموي، مع التركيز على الأسباب الكامنة وراء التباين في تطورها مقارنة بمراكز الخلافة الأموية الأخرى.
حماة في العصر الأموي: نظرة شاملة على مدينة عريقة
تُعد مدينة حماة، المعروفة باسم “أم النواعير”، من المدن السورية العريقة التي تحمل في طياتها تاريخًا غنيًا يمتد لآلاف السنين. تقع حماة في الجزء الغربي من بلاد الشام، وتتميز بموقعها الفريد على نهر العاصي الذي يقسمها إلى شقين، الشرقي المعروف باسم “الحاضر” والغربي باسم “السوق”. وقد اشتهرت المدينة بنظامها المائي المبتكر المتمثل في النواعير، التي كانت تُستخدم لسقاية البيوت والبساتين والمساجد، مما يعكس اعتمادها العميق على الموارد المائية في حياتها اليومية والاقتصادية.
تعود جذور حماة إلى عصور ما قبل التاريخ، حيث دخلت تحت سيطرة النبي داود عليه السلام حوالي عام 1000 قبل الميلاد، وكانت تُعرف آنذاك بمملكة صوبة، وتُصنف ضمن أكبر المدن في المنطقة في ذلك الحين. كما ارتبطت بلاد الشام عمومًا بأسماء تاريخية عديدة مثل بلاد آرام وأرض كنعان وفينيقيا، مما يؤكد عمقها الحضاري وتراثها المتجذر. اقتصاديًا، اشتهرت حماة قبل الفتح الإسلامي بزراعة أشجار الزيتون واستثمارها بشكل كبير، وتُشير الآثار في قراها إلى وجود العديد من مطاحن الزيت ومخازنه، مما يؤكد أهمية هذه الصناعة في المنطقة. وقد بُني سور المدينة الكبير في فترات مبكرة تعود إلى عهد الإمبراطور أنستاسيوس الأول (491-518 ميلادي) أو الإمبراطور جوستنيانوس الأول (527-529 ميلادي)، مما يشير إلى أهميتها الدفاعية والاستراتيجية عبر العصور.
إن التباين بين الأهمية التاريخية والجغرافية والاقتصادية لحماة قبل العصر الأموي، وما شهدته المدينة من تراجع عمراني خلال هذا العصر، يشير إلى علاقة معقدة بين حماة والسلطة الأموية المركزية. هذا التباين يتطلب فهمًا دقيقًا لكيفية تأثير السياسات المركزية والعوامل المحلية على تطور المدن الثانوية ضمن الإمبراطورية.
الدولة الأموية وتأثيرها على حماة
تأسست الدولة الأموية كخلافة إسلامية كبرى، وهي الثانية في تاريخ الإسلام، على يد معاوية بن أبي سفيان عام 661 ميلادي، بعد انتصاره في الفتنة الأولى. اتخذ الأمويون من دمشق عاصمة لخلافتهم، لتصبح بلاد الشام بمثابة القلب النابض للدولة ومصدر قوتها العسكرية. لقد شكل الجيش الشامي أساس قوة الأمويين، مما مكنهم من بسط نفوذهم على الولايات المفتوحة. في أوج اتساعها، امتدت الخلافة الأموية (661-750 ميلادي) على مساحة شاسعة من إفريقيا والأندلس غربًا إلى خراسان والسند شرقًا، لتصبح واحدة من أكبر الإمبراطوريات في التاريخ.
تهدف هذه المقالة إلى تقديم دراسة شاملة لمدينة حماة في العصر الأموي (661-750 ميلادي)، مع التركيز على مكانتها الإدارية، جوانب حياتها الاقتصادية، مظاهرها الاجتماعية والثقافية، وتطورها العمراني، وذلك بالاستناد إلى المصادر التاريخية المتاحة. سنسعى لفهم وضع حماة في العصر الأموي من خلال تحليل التغيرات التي طرأت عليها. كما سنلقي الضوء على الدور الذي لعبته حماة في العصر الأموي ضمن السياق الأوسع للدولة. إن دراسة حماة في العصر الأموي تكشف الكثير عن ديناميكيات المدن الثانوية في تلك الحقبة، وتقدم رؤى قيمة حول التفاعل بين المركز والأطراف. هذه الدراسة ستسهم في تعميق فهمنا لمدينة حماة في العصر الأموي وتاريخها الغني.
حماة ضمن التقسيم الإداري الأموي
فتح حماة ودخولها تحت الحكم الإسلامي (18 هـ / 639 م)
كان دخول حماة تحت الحكم الإسلامي حدثاً محورياً في تاريخها. فبعد أن فتح القائد أبو عبيدة عامر بن الجراح مدينة حمص، توجه إلى حماة في سنة 18 للهجرة، الموافق لعام 639 ميلادي. تلقى أهل حماة أبا عبيدة مذعنين، وتم الصلح معهم على دفع الجزية عن رؤوسهم والخراج على أراضيهم، مما يشير إلى فتح سلمي للمدينة. أقام أبو عبيدة في حماة لبعض الوقت، وخلال هذه الفترة، قام بتحويل كنيستها العظمى إلى جامع، وهو ما عُرف لاحقاً بالجامع الكبير في حماة. هذا التحويل كان ممارسة شائعة في الفتوحات الإسلامية المبكرة، حيث كانت الكنائس الكبرى تُحول إلى مساجد لترسيخ الوجود الإسلامي في المدن المفتوحة.
مكانة حماة الإدارية كجزء من جند حمص ضمن أجناد الشام
بعد الفتح الإسلامي، تم تقسيم بلاد الشام إدارياً وعسكرياً إلى وحدات تُعرف بـ”الأجناد”. هذا التقسيم بدأ في عهد الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب، حيث قُسمت المنطقة إلى أربعة أجناد رئيسية: دمشق، حمص، الأردن، وفلسطين. في العهد الأموي، استقر التقسيم الإداري لبلاد الشام على خمسة أجناد رئيسية، وهي: جند دمشق (وعاصمتها دمشق)، جند حمص (وعاصمتها حمص)، جند قنسرين، جند فلسطين، وجند الأردن.
كانت حماة تابعة إدارياً لجند حمص. هذا يعني أن حماة لم تكن مركز جند بحد ذاتها، بل كانت مدينة ثانوية ضمن جند أكبر. هذا الوضع الإداري لحماة، كمدينة تابعة وليست عاصمة لجند، يقدم تفسيراً مهماً للتراجع العمراني الذي شهدته المدينة خلال العصر الأموي. ففي ظل نظام الأجناد، كانت الموارد والاستثمارات تتركز بشكل طبيعي في العواصم الرئيسية للأجناد، وخاصة في دمشق، عاصمة الخلافة. هذا التركيز على المراكز الإدارية الكبرى أدى إلى تباين في مستويات التنمية بين المدن المختلفة في بلاد الشام.
يوضح الجدول التالي التقسيم الإداري لبلاد الشام في العصر الأموي:
الجدول 1: التقسيم الإداري لبلاد الشام في العصر الأموي
| اسم الجند | حاضرة الجند | مدن رئيسية أخرى | مكانة حماة |
| دمشق | دمشق | – | تابعة لجند حمص |
| حمص | حمص | تدمر | تابعة لجند حمص |
| قنسرين | قنسرين | حلب، مرعش | تابعة لجند حمص |
| الأردن | طبرية | عكا | تابعة لجند حمص |
| فلسطين | اللد | تبوك | تابعة لجند حمص |
نظام الأجناد الأموي وأهميته في إدارة بلاد الشام
كان نظام الأجناد حجر الزاوية في الإدارة الأموية لبلاد الشام، التي كانت بمثابة العاصمة للدولة. سمح هذا النظام بتنظيم الجيوش وتوزيع العطايا على المقاتلين وعيالهم من خلال “ديوان الجند”. كانت نفقات الإدارة الإقليمية تُستمد من موارد تلك الولايات، وتُستخدم لتمويل تجهيز الجيش وبناء المرافق العامة. هذا النظام الإداري العسكري الفعال ضمن للأمويين السيطرة على مناطقهم الشاسعة، ولكنه في الوقت نفسه، أدى إلى تركيز الموارد والاهتمام التنموي في المراكز الرئيسية، مما جعل المدن الثانوية مثل حماة أقل حظاً في التوسع العمراني مقارنة بالعاصمة دمشق أو حتى عواصم الأجناد الأخرى.
الحياة الاقتصادية في حماة
الزراعة: المحاصيل الرئيسية (كالزيتون) ودور نهر العاصي والنواعير
كانت الزراعة هي الركيزة الأساسية للحياة الاقتصادية في حماة خلال العصر الأموي. اشتهرت المدينة بلقب “أم النواعير” بفضل اعتمادها الكبير على نهر العاصي الذي يخترقها. كانت النواعير، وهي آلات رفع المياه التقليدية، تستخدم بشكل واسع لسقاية البساتين والبيوت والمساجد، مما يؤكد الدور الحيوي للمياه في دعم النشاط الزراعي.
حظيت زراعة أشجار الزيتون باهتمام بالغ في حماة، وتُشير الآثار المكتشفة في قراها إلى وجود مطاحن زيت (معاصر الزيتون) ومخازن ومستودعات في كل قرية تقريباً، مما يدل على الأهمية الاقتصادية الكبيرة لإنتاج الزيتون وزيته في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، كانت معيشة الحمويين تعتمد بشكل كبير على الثروة الحيوانية ومنتجاتها مثل اللبن الخاثر والحليب واللحم والسمن. هذه المنتجات كانت متوفرة بكثرة في فصلي الربيع والصيف، لكنها كانت تتناقص بشكل ملحوظ عند شح الأمطار، مما يدل على اقتصاد زراعي ورعوي يتأثر مباشرة بالظروف المناخية.
الصناعة: الحرف والصناعات المحلية (مثل معاصر الزيت) في سياق الازدهار الصناعي الأموي العام
فيما يتعلق بالصناعة، تُشير الآثار المرتبطة بزراعة الزيتون إلى وجود صناعة محلية نشطة لمعالجة المحاصيل الزراعية، مثل معاصر الزيتون. على نطاق أوسع، ساهم التوسع الكبير للدولة الأموية، نتيجة حركة الفتوحات، في تنشيط الحياة الاقتصادية بشكل عام، بما في ذلك قطاع الصناعة. أدى دخول أقاليم جديدة إلى الدولة، بفضل صناعاتها المحلية المتنوعة، إلى تطور هذا القطاع على مستوى الخلافة.
وقد شملت الصناعات في العصر الأموي طحن الحبوب، وعصر الزيتون، واستخراج السكر، وصناعة الورق، والمنسوجات. كانت مصر، على سبيل المثال، المنطقة الأكثر تصنيعاً في بداية الخلافة الأموية. وقد قام معاوية بن أبي سفيان بنقل بعض الفنانين والنجارين إلى المناطق الساحلية في سوريا بهدف إحياء الصناعة هناك، مما يشير إلى اهتمام مركزي بتطوير الصناعات في بلاد الشام.
التجارة: موقع حماة التجاري ضمن شبكة الطرق التجارية الأموية
على الرغم من الازدهار التجاري العام في العصر الأموي، يُذكر أن حماة كانت بعيدة عن البحر وتجارته، ولم تكن حولها مدن كبيرة تشكل سوقاً تجارياً مربحاً لها. هذا يشير إلى أن النشاط التجاري في حماة كان غالباً محلياً ومحدوداً، ويعتمد بشكل أكبر على التبادل الإقليمي للمنتجات الزراعية والرعوية. في المقابل، ازدهرت التجارة في الدولة الأموية بشكل عام بفضل اتساع رقعة الدولة وسيطرتها على أهم الطرق التجارية البرية والبحرية العالمية في ذلك الوقت.
إن وصف اقتصاد حماة بأنه زراعي في المقام الأول، وكونها “بعيدة عن البحر وتجارته” وتفتقر إلى “مدن كبيرة حولها” لتشكيل سوق مربح ، يشير بوضوح إلى أن ازدهارها الاقتصادي كان محلياً ولم يكن مندمجاً بعمق في شبكات التجارة الأموية الأوسع. هذا الاندماج المحدود قد يكون عاملاً مساهماً في التراجع العمراني الذي شهدته المدينة.
فإذا كان اقتصاد حماة يعتمد بشكل أساسي على الإنتاج الزراعي المحلي، فإنه سيكون أكثر عرضة للاضطرابات الداخلية، مثل تحركات القبائل التي تؤثر على قاعدتها الريفية، وأقل قدرة على الاستفادة من الثروة الناتجة عن التجارة الواسعة للخلافة. هذا التباين الاقتصادي، مقارنة بالاقتصاد الإمبراطوري المزدهر، يفسر لماذا لم تشهد حماة نفس مستوى النمو أو الاستثمار الذي شهدته المدن ذات الأهمية التجارية الاستراتيجية، مما ساهم في تراجعها العمراني.
ملاحظة حول توفر المعلومات الاقتصادية الخاصة بحماة مقابل الاقتصاد الأموي العام
تجدر الإشارة إلى أن المصادر المتاحة لا تقدم تفاصيل محددة وكافية عن الحياة الاقتصادية في حماة خلال العصر الأموي بشكل خاص. بدلاً من ذلك، تركز هذه المصادر بشكل أكبر على تاريخ المدينة قبل الإسلام، ودخولها تحت الحكم الإسلامي، وتاريخها الحديث. كما أن العديد من المصادر التاريخية التي تتناول الاقتصاد الأموي تركز على الجوانب الفقهية، مثل أحكام الغنائم والجزية والخراج، وتندر المصادر التي تبحث في ميزانية الدولة وأحوالها المالية بشكل تفصيلي. لذلك، فإن الفهم الكامل للحياة الاقتصادية في حماة خلال تلك الفترة يتطلب استقراءً من الأنماط الاقتصادية العامة للدولة الأموية في بلاد الشام.
الحياة الاجتماعية والثقافية
التركيبة السكانية وتأثير القبائل العربية (مثل كندة وكلب) على عمران حماة
تُشير بعض الروايات التاريخية إلى أن أصول سكان حماة تعود إلى ذرية نوح عليه السلام، مما يؤكد عمق الاستيطان البشري في المنطقة. ومع ذلك، شهد عمران حماة تراجعاً ملحوظاً وخراباً لبعض أبنيتها خلال العصر الأموي. يُعزى هذا التراجع بشكل كبير إلى نفور أهل القرى من عرب كندة الذين استوطنوا صحاري حماة من جهة الشرق، وعشائر كلب الذين سكنوا صحاريها من جهة الغرب. هذا النفور أدى إلى خلو القرى من السكان، وهو أمر كان له تأثير مباشر وسلبي على حماة، حيث كانت المدينة تعتمد بشكل حيوي على هذه القرى في مواردها الاقتصادية وحيويتها، حتى قيل: “لا حياة لحماة إلا بالقرى”.
إن هذا التراجع العمراني، الذي يُعزى تحديداً إلى “نفور أهل القرى من عرب كندة وعشائر كلب” وما ترتب عليه من هجرة سكانية، يشير إلى تحدٍ اجتماعي وديموغرافي كبير أثر بشكل مباشر على رفاهية حماة المادية والبشرية. هذا يدل على أن الديناميكيات القبلية المحلية وتأثيرها على الروابط بين الريف والحضر يمكن أن تكون أكثر ضرراً من الأحداث السياسية الخارجية، حتى في قلب الدولة الأموية. على الرغم من ذلك، فإن استمرار الإشارة إلى شهرة حماة بمدارسها العلمية يقدم صورة متناقضة، مما يشير إلى أن الحياة الفكرية قد تكون قد استمرت أو حتى ازدهرت في بعض الجوانب، ربما اجتذبت العلماء الباحثين عن الاستقرار النسبي أو الرعاية، حتى في خضم التدهور العمراني الأوسع.
المظاهر الاجتماعية العامة في العصر الأموي (الطبقات، الرعاية الاجتماعية، التعليم) وتطبيقها على حماة
شهد العصر الأموي اتساعاً كبيراً للدولة ودخول العديد من الشعوب في الإسلام، مما أدى إلى تزاوج الثقافات وتنوع الحياة الاجتماعية. انقسم المجتمع الأموي إلى طبقات رئيسية: طبقة الخلفاء وأسرهم، طبقة كبار الولاة وكتاب الدواوين، طبقة العلماء والمفكرين، طبقة كبار الأثرياء والتجار ورؤساء العشائر، وطبقة عامة الناس من الزراع والحرفيين.
أولى الأمويون اهتماماً بالرعاية الاجتماعية، وعملوا على مكافحة الفقر والمرض والجهل. شمل ذلك بناء المستشفيات في المدن الكبرى، ورعاية المرضى في السجون والمناطق النائية، وإنشاء دور ضيافة للمسنين، والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة عبر “ديوان الزمنى”. كما قدموا رعاية خاصة للفقراء والمحتاجين، وإعالة الأسر التي فقدت معيلها، وتزويج الشباب، وسداد الديون عن الغارمين.
شمل الاهتمام بالتعليم جميع فئات المجتمع، حيث أرسل الخلفاء المعلمين إلى القبائل الرحل لتعليمهم أمور دينهم والقراءة والكتابة والحساب، واهتموا بتعليم الأيتام. من المتوقع أن حماة، كجزء من الدولة الأموية، قد استفادت من هذه السياسات العامة في الرعاية الاجتماعية والتعليم، وإن لم تتوفر تفاصيل محددة عن تطبيقها في المدينة نفسها.
الحركة العلمية والثقافية في بلاد الشام الأموية وأي إشارات خاصة بحماة
شهد العصر الأموي تطوراً ملحوظاً في العلوم الدينية الإسلامية، واستمر ازدهار الثقافة المسيحية أيضاً في بلاد الشام. كان هناك تطور فكري كبير في مجالات التعليم والعلوم والثقافة، مع دعم الخلفاء لترجمة الكتب الأجنبية إلى العربية، مما أثرى الحياة الفكرية. وقد أشارت المصادر إلى أن حماة اشتهرت بمدارسها العلمية ، مما يدل على وجود نشاط فكري وثقافي محلي، وربما استقطاب للعلماء، حتى في ظل التحديات العمرانية التي واجهتها المدينة. هذا يشير إلى أن الحياة الفكرية والثقافية قد تكون قد حافظت على حيويتها أو حتى ازدهرت في بعض الجوانب، مما جذب العلماء والطلاب الباحثين عن المعرفة.
المنشآت المعمارية والتطور العمراني
الجامع الكبير في حماة: تاريخه، تحويله من كنيسة إلى مسجد في العصر الأموي، وأي سمات أموية باقية
يُعد الجامع الكبير في حماة من أقدم المعالم القائمة في المدينة، ويحمل في طياته طبقات من التاريخ المعماري. تاريخياً، كان الموقع في الأصل معبداً رومانياً يعود للقرن الثالث الميلادي، ثم تحول إلى كاتدرائية مسيحية خلال الفترة البيزنطية، ربما في القرن السادس الميلادي أو حوالي عام 595 م. بعد الفتح الإسلامي لسوريا، تم تحويل الكنيسة البيزنطية إلى مسجد في عام 18 هـ (639 م) على يد الصحابي أبي عبيدة بن الجراح.
هذا التحويل يضع تأسيسه كمسجد ضمن الفترة التي تسبق مباشرة قيام الدولة الأموية، ولكنه استمر كجامع رئيسي في المدينة طوال العصر الأموي. يُذكر الجامع الكبير في حماة كأحد المساجد الكبرى في سوريا خلال العصر الأموي، إلى جانب الجامع الأموي في دمشق والجامع الكبير في حلب وحمص. وقد تعرض الجامع للدمار في عام 1982 وأعيد بناؤه، مما يعني أن السمات الأموية الأصلية قد تكون تغيرت أو أعيد بناؤها وفقاً للتصميم التاريخي.
حالة العمران في حماة خلال العصر الأموي (إشارات إلى تراجع العمران)
ظلت حماة تابعة للخلفاء الراشدين ثم دخلت حكم الأمويين، وقد تناقص عمرانها وخراب بعض أبنيتها “من ذاك الحين”. هذا يشير إلى أن التراجع بدأ أو استمر خلال الفترة الأموية. يُعزى هذا التناقص إلى نفور أهل القرى من عرب كندة وكلب الذين استوطنوا صحاري حماة، مما أدى إلى خلو القرى من السكان، وهو ما أثر سلباً على حماة التي “لا حياة لها إلا بالقرى”. وقد وصف أحمد بن الطيب حماة في سنة 271 هـ (بعد نهاية العصر الأموي بفترة وجيزة) بأنها “قرية عليها سور حجارة، وفيها بناء بالحجارة”، مع نهر العاصي ونواعيرها. هذا الوصف، رغم أنه بعد العصر الأموي، يعكس حالة من التراجع العمراني مقارنة بمدن أخرى مثل بغداد في ذلك الوقت، ويدعم فكرة أن التراجع بدأ في العصر الأموي.
مقارنة بحركة البناء الأموية في دمشق
شهدت العاصمة الأموية دمشق حركة بناء معمارية ضخمة، حيث بنى الأمويون قصوراً رائعة وأول المعالم الدينية الإسلامية الكبرى، مثل قبة الصخرة في القدس والجامع الأموي في دمشق. يُعد الجامع الأموي في دمشق، الذي بُني في عهد الوليد بن عبد الملك (706-715 م)، تحفة معمارية إسلامية. وقد بُني على أنقاض معبد روماني ثم كنيسة، واعتمد في تخطيطه على النموذج النبوي، ليصبح أيقونة في الفن المعماري الإسلامي. هذا يوضح حجم الاستثمار المعماري في العاصمة.
إن التراجع العمراني الموثق في حماة خلال العصر الأموي، والذي يتناقض بشكل حاد مع الإنجازات المعمارية الضخمة في دمشق، يكشف عن نمط من التنمية غير المتكافئة وتركيز الموارد ضمن قلب الدولة الأموية في بلاد الشام. هذا يدل على أنه بينما كانت سوريا هي المركز الاستراتيجي للإمبراطورية الأموية، فإن فوائد هذه المركزية لم تُوزع بالتساوي. فقد تركزت الموارد الإمبراطورية والرعاية المعمارية بشكل كبير في العاصمة، وربما في مراكز الأجناد الرئيسية الأخرى، بينما كانت المدن الثانوية مثل حماة أكثر عرضة للضغوط الاجتماعية والاقتصادية المحلية.
هذا يشير إلى أن تركيز الدولة الأموية كان في المقام الأول على تعزيز السلطة وإبراز العظمة الإمبراطورية من عاصمتها، بدلاً من ضمان تنمية موحدة عبر جميع أراضيها، خاصة تلك التي لم تُعتبر حاسمة استراتيجياً للأهداف العسكرية أو السياسية المباشرة.
التحديات والأحداث البارزة
التحديات التي واجهت حماة خلال الفترة الأموية (مثل هجرة السكان)
كانت أبرز التحديات التي واجهت حماة في العصر الأموي مرتبطة بالتغيرات الديموغرافية والاجتماعية. فقد تناقص عمران المدينة وخراب بعض أبنيتها بسبب “نفور أهل القرى من عرب كندة الذين قطنوا صحاري حماة من جهة الشرق، وعشائر كلب الذين سكنوا صحاريها من جهة الغرب”. أدى هذا النفور إلى خلو القرى من السكان، وهو أمر ذو تأثير مباشر على حماة، حيث كانت “لا حياة لحماة إلا بالقرى” التي كانت تستمد منها موارد ثروتها. هذا يشير إلى ضعف في السيطرة المركزية على الديناميكيات القبلية المحلية أو تأثيرها السلبي على الاستقرار الريفي، مما أثر بشكل مباشر على القاعدة الاقتصادية للمدينة.
أي أحداث سياسية أو اجتماعية محددة ذات صلة مباشرة بالعصر الأموي في حماة
تركز المصادر المتاحة بشكل كبير على حدث الفتح الإسلامي لحماة في 18 هـ (639 م) وتحويل كنيستها إلى جامع. بعد الفتح، ظلت حماة تابعة للخلفاء الراشدين ثم دخلت حكم الأمويين كجزء من جند حمص.
من المهم الإشارة إلى أن هناك ندرة في ذكر أحداث سياسية أو عسكرية كبرى محددة تتمحور حول حماة خلال العصر الأموي (661-750 م). فالعديد من الأحداث التاريخية البارزة المرتبطة بحماة في المصادر، مثل معركة حماة عام 903 م ضد القرامطة، أو أحداث 1964 و1982، تقع خارج النطاق الزمني للعصر الأموي. هذا النقص في الأحداث السياسية الكبرى الخاصة بحماة خلال العصر الأموي يشير إلى أنها لم تكن مركزاً رئيسياً للصراعات السياسية أو العسكرية خلال هذه الفترة.
إن الندرة الملحوظة للأحداث السياسية أو العسكرية الكبرى التي تركزت في حماة خلال الخلافة الأموية، بخلاف فتحها الأولي واندماجها الإداري، يعزز مكانتها كمدينة ثانوية ضمن الهيكل الإداري الأكبر لجند حمص. فلو كانت حماة نقطة استراتيجية حاسمة أو مركزاً للانشقاق السياسي الكبير خلال الخلافة الأموية، لكانت قد ذُكرت بشكل أكثر بروزاً في الروايات التاريخية لهذه الأحداث. إن هدوءها النسبي، مقارنة بالمشهد السياسي المضطرب الأوسع للإمبراطورية الأموية، يشير إلى أنها لم تكن مسرحاً رئيسياً لتلك السرديات الكبرى.
بدلاً من ذلك، يبدو أن تحدياتها كانت أكثر محلية واجتماعية-اقتصادية (مثل تحركات القبائل التي تؤثر على المناطق الريفية)، بدلاً من الانخراط المباشر في صراعات القوى السياسية الكبرى في تلك الحقبة. هذا الغياب للأحداث الكبرى هو بحد ذاته مؤشر، يدل على فترة من الاستقرار النسبي أو ربما الركود، حيث كان مصير حماة يتحدد إلى حد كبير بتبعيتها الإدارية والتحولات الديموغرافية المحلية بدلاً من الاهتمام الإمبراطوري المباشر.
خاتمة
في العصر الأموي، كانت حماة مدينة ذات تاريخ عريق يسبق ظهور الإسلام، وقد حافظت على مكانتها الجغرافية الفريدة على نهر العاصي، مع نظام النواعير الذي كان حيوياً لاقتصادها الزراعي، خاصة في زراعة الزيتون. بعد الفتح الإسلامي السلمي في عام 18 هـ، أصبحت حماة جزءاً لا يتجزأ من الدولة الإسلامية، وتم دمجها إدارياً ضمن جند حمص، وهو أحد الأجناد الخمسة التي شكلت العمود الفقري للإدارة الأموية في بلاد الشام.
على الرغم من الازدهار العام للدولة الأموية، شهدت حماة فترة من التراجع العمراني وتناقص السكان. يُعزى هذا التراجع جزئياً إلى تحركات القبائل البدوية (كندة وكلب) التي أثرت سلباً على القرى المحيطة التي كانت تعتمد عليها المدينة في مواردها وحيويتها. معمارياً، كان تحويل كنيستها الكبرى إلى الجامع الكبير حدثاً محورياً في ترسيخ هويتها الإسلامية، رغم أن الجامع شهد تعديلات وتجديدات لاحقة.
إن الفترة الأموية، على الرغم من كونها مرحلة شهدت تراجعاً عمرانياً لحماة، كانت ذات أهمية حاسمة في ترسيخ هويتها الإسلامية واندماجها الإداري ضمن الخلافة الأوسع. هذا الاندماج التأسيسي وضع الأساس لنهضتها وازدهارها لاحقاً تحت حكم السلالات الإسلامية المتعاقبة، وخاصة الأيوبيين. هذا يشير إلى أن التراجع في العصر الأموي لم يكن انهياراً لا رجعة فيه، بل ربما كان مرحلة من التكيف وإعادة التوجيه ضمن نظام إمبراطوري جديد. فقد وفرت الهياكل الإدارية والمؤسسات الدينية الإسلامية التي أُنشئت خلال هذه الفترة الإطار الضروري لنمو حماة المستقبلي، مما سمح لها بالازدهار عندما اختارت السلالات اللاحقة الاستثمار فيها.
الأسئلة الشائعة
1. ما هي مكانة مدينة حماة قبل العصر الأموي، ولماذا يُعد العصر الأموي فترة تحول في تاريخها؟
قبل العصر الأموي، كانت حماة مدينة عريقة ذات تاريخ يمتد لآلاف السنين، تُعرف بـ”أم النواعير” بسبب نظامها المائي الفريد. دخلت تحت سيطرة النبي داود عليه السلام حوالي عام 1000 قبل الميلاد، وكانت تُعرف بمملكة صوبة، وتُصنف ضمن أكبر المدن في المنطقة. اقتصادياً، اشتهرت حماة في العصر الأموي وما قبله بزراعة الزيتون، وتُشير الآثار إلى وجود العديد من مطاحن الزيت ومخازنه. بُني سورها الكبير في فترات مبكرة تعود إلى عهد الإمبراطورين أنستاسيوس الأول أو جوستنيانوس الأول، مما يؤكد أهمية حماة في العصر الأموي من الناحية الدفاعية والاستراتيجية.
يُعد العصر الأموي فترة تحول لأن المقال يشير إلى تباين بين أهمية حماة قبل العصر الأموي، وما شهدته من تراجع عمراني خلاله. هذا التباين يتطلب فهماً دقيقاً لكيفية تأثير السياسات المركزية والعوامل المحلية على تطور المدن الثانوية ضمن الإمبراطورية الأموية. فبينما كانت دمشق عاصمة الخلافة الأموية تشهد ازدهاراً كبيراً، تأثرت حماة في العصر الأموي بشكل مختلف.
2. كيف دخلت حماة تحت الحكم الإسلامي، وما هي التغييرات الإدارية التي طرأت عليها بعد ذلك؟
دخلت حماة تحت الحكم الإسلامي في سنة 18 للهجرة (639 ميلادي) على يد القائد أبي عبيدة عامر بن الجراح بعد فتحه مدينة حمص. كان الفتح سلمياً، حيث تلقى أهل حماة أبا عبيدة مذعنين، وتم الصلح معهم على دفع الجزية والخراج. أقام أبو عبيدة في حماة في العصر الأموي المبكر لبعض الوقت، وقام بتحويل كنيستها العظمى إلى جامع، وهو ما عُرف لاحقاً بالجامع الكبير في حماة، مما رسخ الوجود الإسلامي في المدينة.
بعد الفتح الإسلامي، تم تقسيم بلاد الشام إدارياً وعسكرياً إلى “أجناد”. كانت حماة في العصر الأموي تابعة إدارياً لجند حمص، مما يعني أنها لم تكن مركز جند بحد ذاتها، بل مدينة ثانوية ضمن جند أكبر. هذا الوضع الإداري كان له تأثير مباشر على التراجع العمراني الذي شهدته المدينة، حيث كانت الموارد والاستثمارات تتركز بشكل طبيعي في العواصم الرئيسية للأجناد، وخاصة في دمشق عاصمة الخلافة الأموية.
3. ما هو نظام الأجناد الأموي، وما مدى أهميته في إدارة بلاد الشام؟
نظام الأجناد هو تقسيم إداري وعسكري لبلاد الشام، بدأ في عهد الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب، واستقر في العصر الأموي على خمسة أجناد رئيسية: دمشق، حمص، قنسرين، فلسطين، والأردن. كان هذا النظام حجر الزاوية في الإدارة الأموية لبلاد الشام، التي كانت بمثابة العاصمة للدولة.
سمح هذا النظام بتنظيم الجيوش وتوزيع العطايا على المقاتلين وعيالهم من خلال “ديوان الجند”. كانت نفقات الإدارة الإقليمية تُستمد من موارد تلك الولايات وتُستخدم لتمويل تجهيز الجيش وبناء المرافق العامة. هذا النظام الإداري العسكري الفعال ضمن للأمويين السيطرة على مناطقهم الشاسعة، ولكنه أدى أيضاً إلى تركيز الموارد والاهتمام التنموي في المراكز الرئيسية، مما جعل المدن الثانوية مثل حماة في العصر الأموي أقل حظاً في التوسع العمراني مقارنة بالعاصمة دمشق أو حتى عواصم الأجناد الأخرى.
4. كيف كانت الحياة الاقتصادية في حماة خلال العصر الأموي؟
كانت الزراعة هي الركيزة الأساسية للحياة الاقتصادية في حماة في العصر الأموي. اشتهرت المدينة بلقب “أم النواعير” لاعتمادها الكبير على نهر العاصي والنواعير لسقاية البساتين والبيوت والمساجد. حظيت زراعة أشجار الزيتون باهتمام بالغ، وتُشير الآثار إلى وجود مطاحن زيت ومخازن في كل قرية تقريباً، مما يدل على الأهمية الاقتصادية الكبيرة لإنتاج الزيتون وزيته في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، اعتمد الحمويون بشكل كبير على الثروة الحيوانية ومنتجاتها.
فيما يتعلق بالصناعة، تُشير الآثار المرتبطة بزراعة الزيتون إلى وجود صناعة محلية نشطة لمعالجة المحاصيل الزراعية مثل معاصر الزيتون. وعلى الرغم من الازدهار التجاري العام في العصر الأموي، يُذكر أن حماة في العصر الأموي كانت بعيدة عن البحر وتجارته، ولم تكن حولها مدن كبيرة تشكل سوقاً تجارياً مربحاً لها، مما يشير إلى أن نشاطها التجاري كان غالباً محلياً ومحدوداً. هذا الاندماج المحدود في شبكات التجارة الأموية الأوسع قد يكون عاملاً مساهماً في التراجع العمراني الذي شهدته المدينة.
5. ما هي العوامل التي أدت إلى التراجع العمراني في حماة خلال العصر الأموي؟
التراجع العمراني في حماة في العصر الأموي يُعزى إلى عدة عوامل. أولاً، وضعها الإداري كمدينة تابعة لجند حمص وليس كعاصمة بحد ذاتها، مما أدى إلى تركز الموارد والاستثمارات في عواصم الأجناد وفي دمشق عاصمة الخلافة. ثانياً، كان التراجع مرتبطاً بشكل كبير بنفور أهل القرى من عرب كندة الذين استوطنوا صحاري حماة من جهة الشرق، وعشائر كلب الذين سكنوا صحاريها من جهة الغرب.
هذا النفور أدى إلى خلو القرى من السكان، وهو أمر كان له تأثير مباشر وسلبي على حماة، حيث كانت المدينة تعتمد بشكل حيوي على هذه القرى في مواردها الاقتصادية وحيويتها، حتى قيل: “لا حياة لحماة إلا بالقرى”. هذا يدل على أن الديناميكيات القبلية المحلية وتأثيرها على الروابط بين الريف والحضر كانت أكثر ضرراً من الأحداث السياسية الخارجية، مما أثر بشكل مباشر على رفاهية حماة في العصر الأموي المادية والبشرية.
6. كيف أثرت التركيبة السكانية وتحركات القبائل العربية على عمران حماة؟
شهد عمران حماة في العصر الأموي تراجعاً ملحوظاً وخراباً لبعض أبنيتها. يُعزى هذا التراجع بشكل كبير إلى نفور أهل القرى من عرب كندة الذين استوطنوا صحاري حماة من جهة الشرق، وعشائر كلب الذين سكنوا صحاريها من جهة الغرب. هذا النفور أدى إلى خلو القرى من السكان، مما كان له تأثير مباشر وسلبي على حماة، حيث كانت المدينة تعتمد بشكل حيوي على هذه القرى في مواردها الاقتصادية وحيويتها، حتى قيل: “لا حياة لحماة إلا بالقرى”.
هذا التحدي الاجتماعي والديموغرافي يشير إلى أن الديناميكيات القبلية المحلية وتأثيرها على الروابط بين الريف والحضر يمكن أن تكون أكثر ضرراً من الأحداث السياسية الخارجية، حتى في قلب الدولة الأموية. على الرغم من ذلك، استمرت الإشارة إلى شهرة حماة في العصر الأموي بمدارسها العلمية، مما يشير إلى أن الحياة الفكرية قد تكون قد استمرت أو حتى ازدهرت في بعض الجوانب، ربما اجتذبت العلماء الباحثين عن الاستقرار النسبي أو الرعاية.
7. ما هو الدور الذي لعبه الجامع الكبير في حماة خلال العصر الأموي؟
يُعد الجامع الكبير في حماة من أقدم المعالم القائمة في المدينة، ويحمل في طياته طبقات من التاريخ المعماري. كان الموقع في الأصل معبداً رومانياً، ثم تحول إلى كاتدرائية مسيحية. بعد الفتح الإسلامي لسوريا في عام 18 هـ (639 م)، تم تحويل الكنيسة البيزنطية إلى مسجد على يد الصحابي أبي عبيدة بن الجراح. هذا التحويل يضع تأسيسه كمسجد ضمن الفترة التي تسبق مباشرة قيام الدولة الأموية، ولكنه استمر كجامع رئيسي في المدينة طوال العصر الأموي.
يُذكر الجامع الكبير في حماة في العصر الأموي كأحد المساجد الكبرى في سوريا، إلى جانب الجامع الأموي في دمشق والجامع الكبير في حلب وحمص. هذا التحويل كان ممارسة شائعة في الفتوحات الإسلامية المبكرة لترسيخ الوجود الإسلامي في المدن المفتوحة، وعمل الجامع كمركز ديني واجتماعي للمدينة في تلك الحقبة، على الرغم من تعرضه للدمار لاحقاً وإعادة بنائه.
8. هل شهدت حماة حركة علمية وثقافية ملحوظة في العصر الأموي؟
على الرغم من التراجع العمراني الذي شهدته حماة في العصر الأموي، فقد أشارت المصادر إلى أن المدينة اشتهرت بمدارسها العلمية. هذا يدل على وجود نشاط فكري وثقافي محلي، وربما استقطاب للعلماء، حتى في ظل التحديات العمرانية التي واجهتها المدينة.
شهد العصر الأموي تطوراً ملحوظاً في العلوم الدينية الإسلامية، واستمر ازدهار الثقافة المسيحية أيضاً في بلاد الشام. كان هناك تطور فكري كبير في مجالات التعليم والعلوم والثقافة، مع دعم الخلفاء لترجمة الكتب الأجنبية إلى العربية. هذه السياسات العامة للدولة الأموية يُتوقع أن تكون قد انعكست بشكل ما على حماة في العصر الأموي، مما سمح للحياة الفكرية والثقافية بالحفاظ على حيويتها أو حتى الازدهار في بعض الجوانب، مما جذب العلماء والطلاب الباحثين عن المعرفة.
9. ما هي أبرز التحديات التي واجهت حماة خلال الفترة الأموية، وهل كانت مركزاً للأحداث السياسية الكبرى؟
كانت أبرز التحديات التي واجهت حماة في العصر الأموي مرتبطة بالتغيرات الديموغرافية والاجتماعية، لا سيما نفور أهل القرى من عرب كندة وكلب واستيطانهم لصحاري حماة. أدى هذا النفور إلى خلو القرى من السكان، مما أثر سلباً على حماة التي “لا حياة لها إلا بالقرى”. يشير هذا إلى ضعف في السيطرة المركزية على الديناميكيات القبلية المحلية أو تأثيرها السلبي على الاستقرار الريفي، مما أثر بشكل مباشر على القاعدة الاقتصادية للمدينة.
من المهم الإشارة إلى أن هناك ندرة في ذكر أحداث سياسية أو عسكرية كبرى محددة تتمحور حول حماة في العصر الأموي (661-750 م). فالعديد من الأحداث التاريخية البارزة المرتبطة بحماة في المصادر تقع خارج النطاق الزمني للعصر الأموي. هذا النقص في الأحداث السياسية الكبرى الخاصة بحماة خلال العصر الأموي يشير إلى أنها لم تكن مركزاً رئيسياً للصراعات السياسية أو العسكرية خلال هذه الفترة، بل مدينة ثانوية ضمن الهيكل الإداري الأكبر لجند حمص.
10. كيف أثرت الفترة الأموية على هوية حماة الإسلامية ومستقبلها؟
على الرغم من أن الفترة الأموية شهدت تراجعاً عمرانياً لمدينة حماة في العصر الأموي، فقد كانت ذات أهمية حاسمة في ترسيخ هويتها الإسلامية واندماجها الإداري ضمن الخلافة الأوسع. فالفتح الإسلامي السلمي للمدينة في عام 18 هـ وتحويل كنيستها الكبرى إلى الجامع الكبير كان حدثاً محورياً في ترسيخ هويتها الإسلامية.
هذا الاندماج التأسيسي وضع الأساس لنهضتها وازدهارها لاحقاً تحت حكم السلالات الإسلامية المتعاقبة، وخاصة الأيوبيين. هذا يشير إلى أن التراجع في العصر الأموي لم يكن انهياراً لا رجعة فيه، بل ربما كان مرحلة من التكيف وإعادة التوجيه ضمن نظام إمبراطوري جديد. فقد وفرت الهياكل الإدارية والمؤسسات الدينية الإسلامية التي أُنشئت خلال هذه الفترة الإطار الضروري لنمو حماة في العصر الأموي وما بعده، مما سمح لها بالازدهار عندما اختارت السلالات اللاحقة الاستثمار فيها.