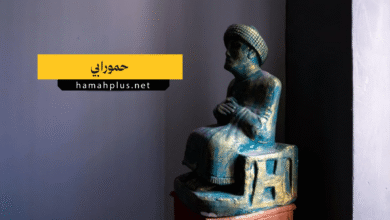حماة في فترة الغزو المغولي: صمود، تحولات، ونهضة تحت الحكم الأيوبي والمملوكي

محتوى المقالة
مقدمة: حماة قبيل عاصفة المغول
تُعد حماة مدينة عريقة ذات تاريخ طويل، يعود استيطانها إلى عصور ما قبل التاريخ، وقد تعاقبت عليها حضارات وممالك عديدة، مما يؤكد أهميتها التاريخية والاستراتيجية عبر العصور. تتميز المدينة بموقعها الاستراتيجي في وسط سوريا، حيث يمر نهر العاصي في قلبها، مما جعلها شريان حياة زراعياً مهماً ومحوراً تجارياً حيوياً في المنطقة. أسهم تنوع تضاريسها، بين السهول الخصبة والجبال الخضراء والوديان الغنية، في دعم الزراعة الوفيرة للحبوب والزيتون والفواكه، التي شكلت أساس معيشة الحمويين. وإلى جانب الزراعة، شملت الأنشطة الاقتصادية في حماة صناعات مثل الدقيق، والمنسوجات، والدباغة، والأسمنت، مما يشير إلى اقتصاد متنوع ونابض بالحياة.
قبيل الاجتياح المغولي، كانت حماة تحت حكم فرع من السلالة الأيوبية منذ عام 1178م، وشهدت في ظلهم ازدهاراً ثقافياً وتجارياً وعلمياً ملحوظاً. وقد أشاد الرحالة ابن جبير في عام 1185م، والمؤرخ الحلبي ابن العديم، بعراقة الحياة في حماة وقصورها وأسواقها ومساجدها ومدارسها ووفرة كل شيء فيها، واصفين إياها بأنها “بلدة عظيمة”.
على الرغم من هذا الازدهار، كان وضع بلاد الشام والدولة الأيوبية قبيل الغزو المغولي يتسم بالضعف والتشرذم. فقد أدت الخلافات الداخلية والصراعات المستمرة بين الملوك الأيوبيين في مصر وبلاد الشام وإقليم الجزيرة إلى إضعافهم بشكل كبير. هذا التشرذم الداخلي دفع بعضهم إلى التحالف مع قوى خارجية، بل وحتى مع الصليبيين الذين كانوا أعداء تقليديين للمسلمين، لتهديد بعضهم البعض.
هذا الوضع من الوهن والتناحر خلق فراغاً في السلطة وأرضية خصبة لقوة خارجية قوية مثل المغول لاستغلالها. على سبيل المثال، أرسل الناصر يوسف، حاكم دمشق، ممثليه إلى منغوليا عام 1251م ليوافق على جعل الشام دولة تابعة للإمبراطورية المغولية “كذريعة لشراء السلام”، بل وحاول استعطاف هولاكو وعرض عليه المساعدة في الاستيلاء على مصر. هذا السلوك يعكس حالة من اليأس والتشرذم التي منعت الأيوبيين من تشكيل جبهة موحدة لمواجهة التهديد المغولي المتنامي، مما جعل بلاد الشام فريسة سهلة للاجتياح.
الغزو المغولي وتأثيره المباشر على حماة (1258-1260)
بدأت الغزوات المغولية لبلاد الشام في أربعينيات القرن الثاني عشر الميلادي، لكنها حققت نجاحاً كبيراً في عامي 1260م و1300م، حيث استولوا على حلب ودمشق. جاء اجتياح الشام بعد سقوط بغداد عام 1258م على يد هولاكو، مما مهد الطريق لتقدمهم غرباً. كان الهدف المغولي هو السيطرة على كامل بلاد الشام، لكن غزواتهم توقفت لاحقاً على يد الدولة المملوكية.
في سياق هذا الاجتياح، تعرضت حماة للدمار عام 1258م. ومع ذلك، فإن تفاصيل هذا الحدث تكشف عن ديناميكية معقدة بين القوة الغازية والسلطة المحلية. بينما تذكر بعض المصادر أن حماة “دمرها المغول عام 1258″، فإن مصادر أخرى تقدم تفصيلاً حاسماً، مشيرة إلى أن حماة “تعرَّضت لخطر الغزو المغولي، واستطاع ملكها الحصول على الأمان، وسلَّم المدينة والقلعة للمغول”.
هذا يشير إلى أن تدمير المدينة لم يكن بالضرورة نتيجة مقاومة عنيفة، بل قد يكون جزءاً من النهج المغولي في الترويع أو نتيجة لعمليات عسكرية سابقة، أو ربما أن تسليم المدينة والقلعة كان محاولة من الملك الأيوبي المنصور الثاني محمد لتخفيف حدة الدمار الشامل والحصول على “الأمان” لسكانها. هذا يلقي الضوء على استراتيجيات البقاء في ظل الاحتلال، حيث لجأ الحاكم إلى حل براغماتي في مواجهة قوة لا تقاوم.
كانت الآثار الأولية للدمار والنزوح على المدينة وسكانها وخيمة. أدت الغزوات المغولية إلى دمار واسع النطاق للمدن، بما في ذلك المساجد والمدارس والمكتبات، وتحويل المدن المزدهرة إلى “مدن أشباح”. يؤكد هروب عائلة أبي الفداء من حماة إلى دمشق عام 1274م (وولادته هناك) بسبب إحاطة المغول بها على أن النزوح كان استجابة فورية وشائعة للتهديد المغولي.
على الرغم من أن هذا الحدث وقع بعد الغزو الأول، إلا أنه يؤكد استمرار حالة عدم الاستقرار والخوف. المصادر العامة تصف الغزوات المغولية بأنها تسببت في “موت ودمار واسعي النطاق” و”نزوح سكاني على نطاق لم يسبق له مثيل”. هذا يشير إلى أن حماة، كغيرها من المدن المستهدفة، شهدت اضطراباً ديموغرافياً كبيراً، حيث فر السكان بحثاً عن الأمان، مما أثر على نسيجها الاجتماعي والاقتصادي حتى قبل أن يتم احتلالها أو تدميرها بالكامل.
حماة في عصر المغول، حماة في قلب الصراع المملوكي-المغولي
كانت حماة لاعباً محورياً في الصراع المملوكي-المغولي الذي حدد مصير بلاد الشام لعدة عقود. تُعد معركة عين جالوت عام 1260م نقطة تحول حاسمة، حيث مثلت انتصاراً مدوياً للمسلمين بقيادة السلطان المملوكي قطز على التتار، وأدت إلى توقف غزوات المغول على الشام بشكل فعال.
كان دور حماة في هذه المعركة بالغ الأهمية. فقد انضم الملك المنصور (صاحب حماة الأيوبي) بجيشه إلى جيش قطز قبل المعركة، ووعده قطز ببلده، ووفى له بذلك بعد النصر، مما يدل على ولائه للمماليك. لم تكن مشاركة الملك المنصور الأيوبي، حاكم حماة، بجيشه في معركة عين جالوت إلى جانب السلطان المملوكي قطز مجرد مشاركة عسكرية، بل كانت قراراً سياسياً استراتيجياً حاسماً. مكافأة قطز للمنصور بإعادة تثبيته على حكم حماة بعد النصر تكشف عن سياسة مملوكية ذكية.
بدلاً من استبدال جميع الحكام الأيوبيين، اختار المماليك دعم أولئك الذين أظهروا الولاء والقدرة العسكرية ضد المغول. هذا أدى إلى استمرارية الحكم الأيوبي في حماة تحت السيادة المملوكية، مما وفر للمماليك استقراراً إدارياً في الشام، وسمح لحماة بالاحتفاظ ببعض من استقلاليتها المحلية، وهو ما مهد الطريق لنهضتها اللاحقة. كان جيش حماة يمثل قوة رئيسية ضمن صفوف المماليك في عين جالوت، مما يؤكد مساهمتها العسكرية الفعالة في هذه المعركة الفاصلة.
لم يتوقف دور حماة العسكري عند عين جالوت، بل استمرت في المشاركة في معارك لاحقة ضد المغول. فقد شاركت قوات حماة في معركة حمص الثانية عام 1281م، حيث شكل صاحب حماة وأمراء المماليك ميمنة الجيش الإسلامي، مما يدل على استمرار دورها العسكري الحيوي. كما استمرت قوات حماة في القتال إلى جانب الظاهر بيبرس ضد المغول والصليبيين وحلفائهم الأرمن، مما يعكس التزامها بالدفاع عن بلاد الشام. علاوة على ذلك، ساهمت حماة أيضاً في استعادة عكا من الصليبيين عام 1291م، مما يبرز دورها في تحرير الساحل الشامي.
وفي الغزو المغولي عام 1299/1300م، استولى المغول على حلب ودمشق، وقرروا الاستيلاء على حماة أولاً قبل دمشق، مما يؤكد أهميتها الاستراتيجية المتواصلة. وتُعد معركة شقحب (مرج الصفر) عام 1303م معركة فاصلة أخرى ضد المغول، وشارك فيها الشيخ ابن تيمية، مما يؤكد استمرار الصراع في محيط حماة وأهمية المنطقة كساحة للمواجهة.
لقد تعرضت المدينة لغزوات متكررة من المغول على مدار عقود (1260، 1271، 1281، 1299/1300، 1303)، مما يظهر حجم التحدي الذي واجهته. إن محاولات المغول المتكررة للسيطرة على حماة ومشاركتها المستمرة في المعارك الدفاعية الكبرى مثل عين جالوت وحمص الثانية وشقحب ليست مجرد أحداث متفرقة، بل هي دليل قاطع على الأهمية الاستراتيجية الحاسمة لحماة. كانت حماة بمثابة نقطة اختناق طبيعية وبوابة دفاعية رئيسية للمماليك في الشام. السيطرة عليها كانت ضرورية للمغول للتقدم جنوباً نحو قلب الدولة المملوكية في مصر. هذا يجعل صمود حماة ليس مجرد قصة محلية، بل جزءاً لا يتجزأ من الاستراتيجية الدفاعية الشاملة للمماليك، مما يؤكد مكانتها كمدينة “حدود عسكرية” حيوية خلال عصر الغزوات المغولية.
فترة التحول وإعادة الإعمار تحت الحكم المملوكي
بعد الانتصار الحاسم في عين جالوت، استعاد المسلمون المدن التي وقعت تحت الاحتلال المغولي، ومن بينها دمشق وحلب، وعادت الأمور إلى نصابها بسرعة. تشير المصادر إلى أن المغول “أُجبروا على التراجع في غضون أشهر في كل مرة من قبل قوات أخرى في المنطقة، وفي المقام الأول المماليك”. كما يذكر أن “عادت الأمور إلى نصابها، وخيم الفرح” بعد عين جالوت. هذه السرعة في استعادة المدن المحتلة، بما في ذلك حماة ضمنياً، تبرهن على الكفاءة العسكرية للمماليك وقدرتهم على التحرك بسرعة بعد الانتصارات. كما أنها تدل على فعالية إدارية في إعادة تنظيم المناطق المحررة، مما وفر الأساس اللازم لجهود إعادة الإعمار والاستقرار، وأكد سيطرة المماليك الجديدة على بلاد الشام.
بعد عين جالوت، أقر السلطان المملوكي الملك المظفر (قطز) الملك المنصور محمد الأيوبي على حكم حماة، تقديراً لجهوده في المعركة. استمر الحكم الأيوبي في حماة تحت السيادة المملوكية حتى عام 1298م، ثم صارت حماة تابعة للمماليك مباشرة في فترة قصيرة، قبل أن يعود حكمها للأيوبيين في شخص أبي الفداء عام 1310م.
تزامنت هذه الفترة مع جهود مكثفة لإعادة الإعمار بعد الدمار الذي خلفه الغزو المغولي. فقد أعاد السلطان الظاهر بيبرس بناء حماة بعد أن دمرها المغول عام 1258م. حقيقة أن السلطان بيبرس، أحد أبرز قادة المماليك، قام بإعادة بناء حماة بعد تدميرها تشير إلى أن عملية إعادة الإعمار لم تكن مجرد مبادرات محلية، بل كانت جزءاً من سياسة مركزية للدولة المملوكية. هذا يوضح التزام المماليك باستعادة البنية التحتية للمدن الرئيسية في الشام التي تضررت من الغزوات المغولية. هذا الدعم الحكومي المركزي كان حاسماً في توفير الموارد والاستقرار اللازمين للتعافي السريع، مما يعكس رؤية المماليك لتعزيز سيطرتهم وشرعيتهم من خلال إعادة إحياء المراكز الحضرية.
جدول 1: حكام حماة الأيوبيون في عصر المغول وما بعده
| الحاكم | فترة الحكم (هـ/م) | أبرز الأحداث/الدور |
| المنصور محمد بن محمود | 642-683هـ / 1244-1284م | تعرضت حماة في عهده لخطر الغزو المغولي عام 1258م، واستطاع الحصول على الأمان بتسليم المدينة والقلعة للمغول. شارك بجيشه في معركة عين جالوت عام 1260م، وأقره المماليك على حكم حماة بعدها. |
| المظفر محمود بن محمد | 683-698هـ / 1284-1298م | حكم بعد وفاة والده، وساد الهدوء الداخلي حماة في عهده، وشارك السلطان قلاوون في معارك كثيرة. |
| ولاة المماليك | 698-710هـ / 1298-1310م | حكم مباشر من قبل المماليك بعد اختلاف الأيوبيين على الخلافة. |
| أبو الفداء المؤيد عماد الدين إسماعيل | 710-733هـ / 1310-1331م | أعاد حكم الأيوبيين إلى حماة، وحقق نهضة عمرانية وعلمية واقتصادية، وكان صديقاً مقرباً للسلطان الناصر محمد بن قلاوون. |
| الأفضل ناصر الدين محمد بن أبي الفداء | 733-742هـ / 1331-1341م | خلف والده، لكن حكمه شهد تراجعاً وعُزل على يد المماليك، لتصبح حماة نيابة مملوكية دائمة. |
| ملاحظة: هذا الجدول يركز على الحكام الأيوبيين الذين عاصروا فترة الغزو المغولي وما تلاها مباشرة، مع الإشارة إلى فترات الحكم المملوكي المباشر. |
عصر أبي الفداء: ذروة النهضة في حماة
يمثل عصر الملك المؤيد أبي الفداء ذروة النهضة في حماة بعد صدمة الغزوات المغولية. أبو الفداء هو إسماعيل بن علي بن محمود بن محمد بن أيوب، من سلالة الأيوبيين، وكُني بأبي الفداء ولقب بعماد الدين والملك المؤيد. ولد في دمشق عام 1274م، وذلك عندما فرت عائلته من حماة إثر إحاطة المغول بها، ثم عاد إلى حماة وهو في شهوره الأولى. نشأ في بيئة مليئة بالتحديات والصعوبات، وجمع بين الخبرة العسكرية والإدارية والعلمية، مما أهله ليكون قائداً بارعاً وعالماً مثقفاً. حكم حماة من عام 1310م حتى 1331م، وشهدت فترة حكمه استقراراً وازدهاراً، وكان مرتبطاً بصداقة قوية مع السلطان المملوكي الناصر محمد بن قلاوون.
إن قصة حياة أبي الفداء تمثل تحولاً لافتاً في دور النخبة الأيوبية. فعلى الرغم من أن عائلته فرت من حماة بسبب تهديد المغول، إلا أنه نشأ ليصبح ليس فقط حاكماً، بل عالماً ومؤرخاً وجغرافياً بارزاً. هذا يشير إلى أن الطبقة الحاكمة الأيوبية، حتى بعد فقدان جزء كبير من سلطتها المستقلة لصالح المماليك، تكيفت مع النظام الجديد من خلال التركيز على الإدارة المحلية، ورعاية العلوم، والنهوض العمراني. علاقته القوية بالسلطان المملوكي الناصر محمد تدل على أن المماليك شجعوا هذا النوع من القيادة الفكرية والتنموية في ولاياتهم التابعة، مدركين قيمتها للاستقرار والازدهار، بدلاً من مجرد السيطرة العسكرية. هذا التكيف سمح لحماة بتحقيق نهضة ثقافية وعمرانية ملحوظة.
اعتنى أبو الفداء بمدينة حماة عناية فائقة، وبنى وحسن العديد من مبانيها، مما عكس رؤيته لتطوير المدينة. من أبرز منشآته جامع الدهشة (جامع أبي الفداء نفسه)، حيث شيد ضريحاً له فوقه قبة ومئذنة مثمنة. كما أضاف كتلة بناء إلى الجامع النوري وجعله مدرسة لتدريس الفقه الشافعي، سميت “الروشن”، مع قبو لمسير الناس، مما يدل على اهتمامه بالتعليم والبنية التحتية. هذا التطوير العمراني والعلمي جعل حماة مركزاً ثقافياً وعلمياً مرموقاً في ذلك العصر، حتى لقبت بـ”مدينة أبي الفداء” تكريماً لإسهاماته.
إن المشاريع العمرانية الواسعة التي قام بها أبو الفداء تتجاوز مجرد البناء. فبعد الدمار الواسع الذي خلفه الغزو المغولي ، كانت هذه الجهود بمثابة فعل واعٍ للتعافي الحضاري وتأكيد على استعادة الاستقرار والازدهار. بناء المساجد والمدارس وتحسين الأماكن العامة يرمز إلى إعادة تأكيد الحياة الحضرية الإسلامية والنشاط الفكري. لقد كانت تجسيداً مرئياً لتجاوز صدمة الغزو وإعادة بناء مجتمع حيوي، مما يدل على الروح الصامدة للمنطقة وقدرتها على النهوض من الرماد.
على الصعيد العلمي والثقافي، كان أبو الفداء رجلاً جامعاً لأشتات العلوم، وقد صنف في كل علم تصنيفاً أو تصانيف، مما يدل على سعة علمه. أشهر أعماله كتاب “مختصر في أخبار البشر” في التاريخ و”تقويم البلدان” في الجغرافيا، وترك للمكتبة العربية والإنسانية 12 كتاباً طبع منها ثلاثة نالت شهرة عالمية كبيرة. وقد اعتمد لقب “أبي الفداء” تقديراً لإنجازات الملك الأيوبي وإرثه الحضاري في المنتدى الأدبي عام 1925م.
على الرغم من أن الغزو المغولي أدى إلى تعطيل الحركة العلمية وتدمير المكتبات في بعض المناطق ، فإن الإنتاج العلمي الغزير لأبي الفداء يوضح أن الحياة الفكرية في مناطق مثل بلاد الشام لم تستمر فحسب، بل ازدهرت أيضاً. أعماله في التاريخ والجغرافيا لم تكن مجرد تجميع، بل كانت مساهمات مهمة. هذا يشير إلى أن البنية التحتية الفكرية (العلماء، المعرفة المتراكمة، الرعاية) في الشام كانت مرنة بما يكفي لاستيعاب صدمة الغزوات المغولية، وتحت حكم المماليك والأيوبيين المستقر، تمكنت من الازدهار. هذا يسلط الضوء على أهمية الرعاية الفردية والقيادة المحلية في الحفاظ على المعرفة وتقدمها خلال الأوقات العصيبة.
بفضل حنكته وصبره وشجاعته، استطاع أبو الفداء أن يعيد بناء حماة ويطورها عمرانياً وعلمياً واقتصادياً، مما جعلها تزدهر وتصبح مركزاً مهماً في بلاد الشام. هذا الازدهار هو نتيجة مباشرة للاستقرار السياسي الذي وفره الترتيب المملوكي-الأيوبي، والحكم الفعال لأبي الفداء. بينما كان التأثير الاقتصادي العام للغزوات المغولية سلبياً للغاية، مما أدى إلى تدمير الزراعة والتجارة والفقر ، فإن تعافي حماة تحت قيادة أبي الفداء يظهر أنه بمجرد زوال التهديد المباشر وتأسيس إطار سياسي مستقر، يمكن للحياة الاقتصادية أن تنتعش، مدفوعة بقيادة محلية فعالة تعطي الأولوية للتنمية واستعادة شبكات التجارة.
الآثار طويلة الأمد للغزو المغولي على حماة
تركت الغزوات المغولية آثاراً عميقة وطويلة الأمد على حماة، شملت التغيرات الديموغرافية والاجتماعية، وتأثيرات اقتصادية واسعة، وتحولات ثقافية وفكرية.
على الصعيد الديموغرافي والاجتماعي، أدت الغزوات المغولية إلى قتل وتشريد أعداد كبيرة من السكان في المناطق التي اجتاحوها، وتحويل المدن إلى مدن أشباح. كما تسببت في نزوح سكاني واسع النطاق لم يسبق له مثيل في أوراسيا، خاصة في الصين، مما أثر على التركيب الديموغرافي للمناطق المتأثرة.
على الرغم من عدم وجود بيانات ديموغرافية مباشرة مفصلة عن حماة بعد الغزو المغولي في المصادر المتاحة، فإن التأثير العام للغزوات المغولية على السكان (من قتل جماعي ونزوح وخوف) يشير إلى أن حماة، التي دمرت وفر سكانها منها ، شهدت اضطراباً ديموغرافياً كبيراً. ومع ذلك، فإن إعادة الإعمار اللاحقة على يد بيبرس والازدهار في عهد أبي الفداء يعني ضمناً عودة السكان، سواء من خلال عودة اللاجئين أو استقطاب مستوطنين جدد. هذا يشير إلى ديناميكية من الانخفاض السكاني الأولي تليها فترة من إعادة التوطين والتعافي الديموغرافي، مما يسلط الضوء على مرونة المراكز الحضرية في جذب الناس بمجرد استعادة الاستقرار.
أما التأثير على الاقتصاد والتجارة والزراعة، فقد كان سلبياً للغاية. أثرت الغزوات سلباً على الزراعة والتجارة في المناطق المتأثرة، حيث توقف الفلاحون عن الزراعة بسبب الدمار والخوف، مما أدى إلى نقص الحبوب والمجاعة. كما دمر المغول أنظمة الري في إيران والعراق، مما أدى إلى نقص الغذاء والموت جوعاً، وهذا يشير إلى نمط تدميري واسع النطاق. كان اقتصاد حماة يعتمد بشكل كبير على الزراعة، بفضل سهولها الخصبة ونهر العاصي.
التأثير العام للغزوات المغولية على الزراعة كان مدمراً، مع تدمير المحاصيل وتخلي الفلاحين عن الزراعة بسبب الخوف. هذا يعني أن القاعدة الزراعية لحماة كانت ستعاني بشدة، مما يؤدي إلى نقص الغذاء وصعوبات اقتصادية. وبالتالي، فإن الازدهار اللاحق في عهد أبي الفداء يمثل تعافياً كبيراً في هذا القطاع الحيوي، والذي تحقق على الأرجح من خلال استعادة الإنتاج الزراعي وشبكات التجارة، مما يؤكد أهمية الحكم المستقر للانتعاش الاقتصادي.
شهدت الحياة الثقافية والفكرية في حماة وبلاد الشام تحولات مهمة في ظل الحكم المملوكي. على الرغم من الدمار الأولي، استمرت العلوم والآداب في بلاد الشام ومصر، واستمر التدريس وتلقي العلوم، مما يدل على مرونة الحياة الفكرية. وقد أثر تحول الدولة الإلخانية (المغول في إيران) للإسلام إيجاباً على إحياء العلوم والنشاطات الثقافية وتشجيعها، مما خلق بيئة إقليمية داعمة للتبادل الفكري. علاوة على ذلك، عزز الأيوبيون (والمماليك لاحقاً) الهيمنة السنية ببناء العديد من المدارس (المدارس الإسلامية للقانون) في المدن الكبرى، مما ساهم في ترسيخ الهوية الثقافية. بعد هزيمة المغول الذين لم يكونوا مسلمين في بدايتهم، قام المماليك بتعزيز الإسلام السني بشكل نشط، كما يتضح من بناء المدارس الدينية.
على الرغم من أن هذا المقتطف يشير إلى العصر الأيوبي بشكل عام، إلا أنه يعكس اتجاهاً أوسع في فترة ما بعد المغول. الصدمة التي أحدثتها الغزوات المغولية، والتي اعتبرها الكثيرون عقاباً إلهياً ، أدت إلى إعادة التأكيد على الأرثوذكسية الدينية وتعزيز المؤسسات الإسلامية مثل المدارس. بالنسبة لحماة، تحت السيادة المملوكية ومع حكام مثل أبي الفداء الذي بنى المدارس ، عنى ذلك بيئة ثقافية وفكرية أعطت الأولوية للتعلم الإسلامي السني، مما ساهم في النهضة الفكرية للمدينة وترسيخ هويتها الدينية في مواجهة التهديدات الخارجية والاضطرابات الداخلية.
خاتمة: حماة نموذجاً للصمود والتعافي الحضاري
واجهت حماة خلال عصر المغول تحديات وجودية غير مسبوقة، تمثلت في الدمار الشامل والنزوح السكاني المتكرر والاضطرابات الاقتصادية جراء الغزوات المغولية المتتالية. لقد كانت المدينة، بحكم موقعها الاستراتيجي، في قلب الصراع الدائر بين المغول والمماليك، مما عرضها لضربات متكررة.
ومع ذلك، أظهرت حماة صموداً لافتاً. يعزى هذا الصمود إلى عدة عوامل محورية: أولاً، حكمة قيادتها المحلية المتمثلة في الأسرة الأيوبية، التي سعت للحفاظ على المدينة وسكانها حتى في ظل الضغوط الهائلة. ثانياً، دورها الحيوي في المقاومة العسكرية إلى جانب المماليك في المعارك الفاصلة مثل عين جالوت وحمص الثانية، مما أكسبها ثقة المماليك ودعمهم.
تعافت المدينة بشكل ملحوظ بفضل جهود إعادة الإعمار التي قادها كل من المماليك (ممثلة بالسلطان بيبرس) ثم الملك الأيوبي أبي الفداء. لقد حول أبو الفداء حماة إلى مركز للنهضة العمرانية والعلمية، مستفيداً من الاستقرار الذي وفره الحكم المملوكي. هذا التعافي لم يكن مجرد استعادة لما فات، بل كان نهضة شاملة أعادت للمدينة مكانتها كمركز حضاري مزدهر في بلاد الشام.
تُعد حماة بذلك مثالاً بارزاً على قدرة المدن الإسلامية على الصمود في وجه الكوارث الكبرى والتعافي منها، وإعادة بناء نفسها لتصبح مراكز حضارية مزدهرة. تجسد قصة حماة في عصر المغول العلاقة المعقدة والبراغماتية بين القوى المركزية (المماليك) والسلطات المحلية (الأيوبيون)، وكيف يمكن للتعاون والولاء أن يؤدي إلى فترات من الاستقرار والازدهار حتى في ظل التهديدات المستمرة. يظل إرث أبي الفداء، العالم والحاكم، شاهداً على هذه الفترة، مؤكداً على أهمية العلم والمعرفة في بناء الحضارات وصونها، وعلى قدرة الإرادة البشرية على تجاوز المحن وإعادة تشكيل المستقبل.