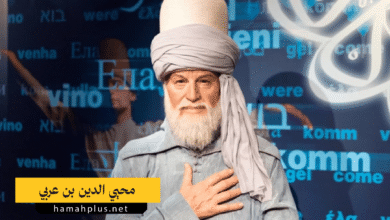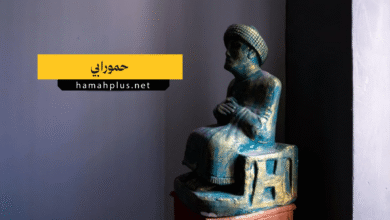النسيج في سوريا: تاريخ ورمزية وصناعة من الحرير إلى القطن

محتوى المقالة
مقدمة
يهدف هذا المقال إلى تقديم معالجة أكاديمية شاملة ظاهراتية-تاريخية-اقتصادية لقطاع النسيج السوري ضمن منظور متعدد الطبقات يعاين المادة والقيمة والمعنى.
وتفترض هذه الدراسة أن فهم “النسيج في سوريا” بوصفه ممارسة مادية وحرفة وفنّاً وصناعة، يتيح قراءة النفوذ المتبادل بين الاقتصاد والسياسة والثقافة والدين.
في هذا الإطار، يتجاوز “النسيج في سوريا” كونه سلسلة تقانات لإنتاج القماش إلى كونه نظاماً رمزياً يعيد تشكيل الهوية المحلية والذاكرة الجمعية وطرائق العيش.
وعليه، لا يمكن بمقاربة اختزالية التمييز بين “الماضي” بوصفه تراثاً ثابتاً و”الحاضر” بوصفه اقتصاداً محضاً؛ إذ إن “النسيج في سوريا” يثبت حضوراً متواصلاً في هذين البعدين معاً، ويعيد تشكيلهما بالتدريج عبر التبادل التجاري، والسياسات العامة، والتحولات الاجتماعية، وحركية السوق العالمية.
تنقسم الدراسة إلى محاور تاريخية وأنثروبولوجية واقتصادية وتقنية، وتستند إلى ما توفر من وثائق ومشاهدات ميدانية وشهادات صناعيين، وتلج في تفاصيل سلسلة القيمة من القطن حتى الألبسة مروراً بالحلج والغزل والنسيج والصباغة والتصميم.
إن تتبّع “النسيج في سوريا” على هذا النحو يُظهر أن القطاع لم يكن يوماً منفصلاً عن سياقه الحضاري، بل ظل يتغذى من تدفقات طريق الحرير، ومن تقاليد الطراز الإسلامي، ومن شبكات الإمداد والأسواق الإقليمية، ما يجعل “النسيج في سوريا” مجالاً تفسيرياً ثرياً لإعادة قراءة التاريخ الاجتماعي والاقتصادي للسوريين.
رمزية النسيج بين الميثولوجيا والدين والاجتماع
يعود حضور الرمزية النسيجية إلى أقدم المدونات، حيث ظهر تشابك السدى واللحمة رمزاً للزواج والاتحاد في أساطير الشرق الأدنى القديم.
إن قراءة هذا الرمز في ضوء “النسيج في سوريا” تُبرز التلازم بين العُرى الاجتماعية وشبكات الخيوط، إذ يرد لدى الرواة أن جلجامش ارتدى في زفافه حزاماً يرمز إلى اندماج الخيوط.
وتستمر هذه الرمزية في التقليدين المسيحي والإسلامي عبر الحجاب والستارة والأقمشة الطقسية، حيث يوفّر الحجاب تدرّجاً بين المقدّس واليومي، ويُعدّ ستار المحراب امتداداً لتقاليد بيزنطية وساسانية أعادتها المدن الإسلامية توظيفاً جمالياً ووظيفياً.
في هذا الإطار، يمنح “النسيج في سوريا” مثالاً واسع الدلالة: السجادة بوصفها فراشاً للعبادة يفصل الجسد عن أرض دنيوية ويقيم بديلاً مقدساً لها؛ والكسوة بوصفها جسداً للأمكنة المقدسة؛ والأكفان بوصفها جسور عبور من الزمن إلى الروح.
بهذا المعنى، لا تبدو ممارسة “النسيج في سوريا” مجرد إتقان تقني، بل هي في عمقها تعبير عن فهم حسّي للطقس والعمران، وعن ترتيب بصري ينسج طبقات المعنى على السطوح والأجساد.
ويكتسب هذا البعد أهمية مضاعفة حين نتذكر أن أثاث البيوت الدمشقية والحلبية التقليدية تشكّل من قماش ومساند وسجاد وستائر، ما يجعل “النسيج في سوريا” مكوِّناً تأسيسياً لثقافة الضيافة والراحة وتشكيل الفضاء الداخلي.
إن هذه القراءة الرمزية لا تُغني عن القراءة المادية لكنها تكملها: إذ لا يمكن تفكيك القيم المضافة الجمالية والاجتماعية دون إدراك أن “النسيج في سوريا” ظل وسيطاً معرفياً بين المرئي والغيبي، وبين ما يُتاح لمسه وما يُراد ترميزه في الحياة اليومية والطقس.
حرير البحر وبدايات فاخرة
تفيد الشواهد بأن الحرير البحري، أو ما عُرف بالبيسوس، مثّل إحدى أقدم المواد التي نُسجت في البيئة السورية قبل ما يزيد عن ألفي عام.
تُنتج أصداف القلم (Pinna nobilis) خيوطاً حريرية ذهبية اللون تلتصق بها بالصخور، وهي خيوط نادرة وعالية القيمة وشقّت لنفسها مكانة في الأقمشة الفاخرة المرتبطة بالنخب.
هنا يضيء البحث على أن “النسيج في سوريا” عرف تعددية مبكّرة في مصادر الخامات، واحتضن مواد بحرية وطبيعية قبل انتشار حرير دودة القز.
ومع صعود الإسلام، توافرت شروط بيئية ومناخية على خط العرض الأربعين تقريباً، ما أتاح ازدهار زراعة التوت وتربية دودة القز في الجبال والوديان والسواحل القريبة، لتُفتح صفحة جديدة من تاريخ الحرير.
من هذه الزاوية، لم يكن انتقال “النسيج في سوريا” من حرير البحر إلى حرير القز مجرد تبدل في الخامة، بل تغيّراً في أنماط الإنتاج والسوق، إذ تكثّف العمل في مشاغل النسيج مع اتساع الطلب الحضري وتبدلات الأذواق، لا سيما في دمشق التي تحولت مركزاً سياسياً واقتصادياً وثقافياً.
ورغم أن الأقمشة الحريرية ظلّت مرتبطة بالعليّة والرموز الدينية والسياسية، فإن “النسيج في سوريا” احتفظ بتكوين طبقي-حِرَفي متنوع، يشمل صناعات منزلية وورشاً صغيرة ومعامل كبرى، وهو ما رسّخ مهارات متوارثة تعد اليوم خزّاناً معرفياً ينبغي توثيقه وتعزيزه ضمن مقاربة التنمية الثقافية المستدامة.
وتنعكس هذه الطبقات في المصطلحات المحلية للأقمشة، وفي النقوش والزخارف، وفي استعمال الخيوط الذهبية والفضية، ما يبرز “النسيج في سوريا” بوصفه مرآة لأذواق مدينة شرقية كوزموبوليتية.
الطراز، الكسوة، والتبادل عبر المتوسط
تاريخ الطراز الإسلامي يفتح نافذة على البنية المؤسسية لـ “النسيج في سوريا”.
فقد ظهرت دور الطراز كمعامل نسج رسمية ملحقة بالخلافة، وتحوّلت النقوش الكتابية على الأقمشة إلى دعاية سياسية-دينية، إضافة إلى كونها علامات جودة.
وفي عهد الأمويين والعباسيين، تشكّلت تقاليد كسوة الكعبة بالديباج الأبيض ثم الأسود المرصع بخيوط ملونة وذهبية وفضية، وكانت الكسوة تُنسج في مرافق الطراز، فتتبدّل ألوانها وتفاصيلها تبعاً لصناّعها، متخذة بعداً سياسياً يرمز للسيادة.
مع انتقال عاصمة الدولة الأموية إلى دمشق عام 661 م وتأسيس أول دار طراز فيها سنة 665، تعزّزت المكانة المركزية لـ “النسيج في سوريا” على مستوى الإنتاج والرمزية معاً.
على الضفة الأخرى من المتوسط، لعبت الأقمشة الإسلامية دوراً لاهوتياً-فنياً في الكنائس الأوروبية؛ كُفنت بها بقايا القديسين والأساقفة، وظهرت نقوش تشبه الطراز على ملابس السيدة في لوحات نهضوية، إذ أعاد رسامون إيطاليون إنتاج الخطوط العربية دون معرفة مضامينها، مستمدّين من ألقها الجمالي.
هذه الوقائع تُظهر كيف عبر “النسيج في سوريا” الحدود كسلعة ورمز ومعنى، وكيف تمفصلت مسارات الحرب والسلم في نقل الأقمشة: هدايا سياسية، غنائم، تبادل تجاري، تقليد فني، وإعادة توطين للرموز في سياقات جديدة.
إن القراءة المقارنة لفنون الطراز والكسوة والقطع الليتورجية في متاحف العالم (مثل ستولا أسقف النبك في متروبوليتان) تُبرهن أن “النسيج في سوريا” حمل معه سرديات لاهوتية وجمالية واقتصادية في آن واحد، وأنه ظل وسيطاً بين الحُسن والسلطة، وبين السوق والطقس.
طريق الحرير وتشكّل الهوية النسيجية
على امتداد قرون، لعبت سوريا دور محطة متوسطة على طريق الحرير، فكانت نقطة التقاء للبضائع والأفكار والتقنيات.
تعاظم هذا الدور حين امتزجت مهارات الحرفيين المحليين مع مؤثرات شرقية وغربية، فظهرت أقمشة تحمل روح الشرق ورصانة الغرب بلمسة سورية فريدة.
في هذا السياق، يتبدّى “النسيج في سوريا” بوصفه نتاجاً لعلاقات مسار ومساحة؛ ليس فقط لأن الطريق نقل الحرير إلى الأسواق، بل لأنه أعاد صوغ البنى المهنية وتقاليد الزخرفة وذائقة الألوان ونظم القياس والقطع.
وتظهر آثار ذلك في مدن مثل دمشق وحلب وتدمر، حيث اكتُشفت مخابئ من المنسوجات القديمة، وبينها أكثر من 2000 قطعة حرير في تدمر العائدة إلى العصر الروماني-الشرقي.
هنا تتبدى أهمية النظر إلى “النسيج في سوريا” خارج ثنائية تراث/صناعة: فهو نمط معيش، وذاكرة حرف، وتبادل ثقافي، وسياسة سوق.
وتكشف أسواق الأقمشة الشعبية التي ظلّت حتى العقدين الماضيين نابضة بأقمشة مزخرفة غنية اللون – الأزرق والأصفر والأحمر مع خطوط الذهب والفضة – كيف أن “النسيج في سوريا” رسم صورة ذائقة عامة، وأصبح جزءاً من اقتصاد الهدايا والسياحة والاقتناء، قبل أن تعصف به الحرب وتغيّرات القدرة الشرائية.
ويؤكد هذا المنظور التاريخي أن أي نهضة مستقبلية إنما تُبنى على إعادة ترسيم الصلة بين السلسلة الإنتاجية والمعنى الثقافي، بما يُعيد لـ “النسيج في سوريا” حضوره المركّب في السوق والذاكرة معاً.
من الحرير إلى القطن: تحوّل بنيوي في المادة والسوق
رغم استمرار تقاليد الحرير الدمشقي والدمسكو والبروكار، عرف القرن العشرون تحولاً بنيوياً بانتقال ثقل الصناعة إلى القطن مع نمو زراعته وانتشارها.
تحولت حقول الجزيرة والفرات وسهل الغاب وغيرها إلى خزّان خام للغزل والنسيج، وتوسعت معامل القطاع العام والخاص، فتسلسلت حلقات حلج وغزل ونسيج وصباغة وتفصيل.
وتاريخياً، كانت فترات الذروة تُقاس بتكامل الحلقة الزراعية والصناعية والتصديرية.
خلال سنوات سابقة للأزمة، ساهمت الصناعات النسيجية بنحو 27% من صافي الناتج الصناعي غير النفطي، وقرابة 45% من الصادرات غير النفطية، وشغلت قرابة 30% من العمالة الصناعية، مع تسجيل نحو 24 ألف منشأة رسمية.
هذا التحول لم يكن مادياً فحسب؛ لقد أعاد تعريف “النسيج في سوريا” كاقتصاد كثيف العمل، شديد التأثر بأسعار الطاقة والنقل وحركة العملات وسياسات التجارة.
بيد أن خروج مساحات زراعية عن الإنتاج بعد 2011، وتراجع كميات القطن المستلمة رسمياً من قرابة 628 ألف طن (2010) إلى أقل من 20 ألف طن (2021)، أخلّ بالحلقة الأولى من السلسلة، فانعكس ذلك على الحلج والغزل، ثم على النسيج والملابس.
وتكشف هذه الأرقام أن استعادة توازن “النسيج في سوريا” تمرّ عبر معالجة دقيقة لمحددات الأمن الزراعي-الصناعي معاً، وبتصميم سياسات تضمن استقرار العرض ومواصفات الخامة وكلفتها، لضمان انسيابية الإنتاج والتصدير.
سلسلة القيمة: من الحقل إلى القماش
تقوم سلسلة القيمة على حلقات متكاملة: الزراعة (القطن)، الحلج، الغزل، النسيج، الصباغة والتحضير والطباعة، التصميم، والملابس الجاهزة، إضافة إلى اللوجستيات والتمويل والتسويق.
في حلقة الزراعة، تتصدر الإشكالات تقلب المساحات، وكلفة المستلزمات، وجودة البذار، وأساليب الري، ونوعية القطاف.
أما في الحلج، فتبرز إعاقة تشغيل المحالج بكامل طاقتها، وتدني نوعية القطن المحبوب المشوب بالشوائب، والتشابكات المالية بين المؤسسات العامة.
وفي الغزل، تعاني الشركات من نقص القطن المحلوج، وقدم خطوط الإنتاج، وارتفاع كلفة الطاقة ونقص اليد العاملة الفنية.
هذه الاختناقات تمتد إلى النسيج الذي يعاني بدوره من عدم استقرار توريد الغزول بالكميات والأنواع والجودة المطلوبة، ومن اتساع التهريب.
وتزداد تعقيدات السلسلة مع الصباغة والتحضير بسبب ارتفاع كلفة الأصبغة والطاقة والمياه، وتحديات الامتثال البيئي.
في مرحلة التصميم، يُعد ضعف الاستثمار في رأس المال الإبداعي أحد أعطاب “النسيج في سوريا”، إذ يفتقر كثير من المنشآت إلى أقسام تصميم متخصصة قادرة على التقاط توجهات الموضة وبناء هويات علامات قوية.
وفي الملابس الجاهزة، تتسع الهوّة بين إمكانات التصنيع المرنة (ميزة تاريخية سورية) وبين اختناقات التصدير والتمويل والشحن والامتثال للمعايير، ما يقلص القيمة المضافة الممكنة.
إن هذه القراءة التحليلية تُظهر أن إصلاح “النسيج في سوريا” لا يكون بإجراء واحد، بل بمنظومة سياسات تعالج الترابطات الدقيقة بين الحلقات، وتعيد ضبط الحوافز والضرائب والطاقة والتمويل والمعايير والتعليم والتدريب.
الصباغة والتصميم والملابس: حيث تتبلور القيمة المضافة
في الصناعات الكثيفة العمل، تتجلى القيمة المضافة النهائية في طبقات الإنهاء الجيد والتصميم والتسويق.
الصباغة والتحضير، كحلقة تقنية، تتطلب ماء وطاقة وخبرة كيميائية، ومعايير بيئية صارمة.
التحول إلى الأصبغة الصديقة للبيئة، وإعادة تدوير المياه، والاستثمار في آلات ذات تقنية نظيفة، وتأسيس محطات معالجة مركزية للتجمعات الصناعية، عناصر ضرورية لرفع جودة الحلقة وخفض كلفها.
أما التصميم، فيبقى نقطة ضعف هيكلية.
المتاح من مبادرات الجمعية السورية لمصممي الأزياء وجهود التدريب لا يكفي إذا لم تُنشأ برامج أكاديمية تطبيقية، وتُبنى جسور مستدامة مع بيوت التصميم الإقليمية والدولية.
هنا يقترن مستقبل “النسيج في سوريا” بقدرة المصممين والصناعيين على ابتكار سلاسل مواسم قصيرة في الملابس النسائية، وعلى تطوير خطوط كلاسيكية مستقرة للأسواق المحافظة، وعلى توظيف العناصر التراثية في أزياء معاصرة (ومنها الأزياء المحتشمة) دون الوقوع في الاستشراق الذاتي.
في الملابس الجاهزة، تُظهر التجربة السورية مقدرة عالية على تنفيذ طلبيات صغيرة ومتوسطة بمرونة زمنية وتكلفة تشغيلية معقولة، وهي ميزة تنافسية على أسواق الجوار، لكنها تحتاج إلى ضمان جودة ثابتة وشهادات مطابقة ومعايير قياس محدّثة.
إن الاستثمار في التصميم والتغليف والبيع عبر التجارة الإلكترونية، وربط المراكز الصناعية بمستودعات إقليمية (إسطنبول، بغداد، عمّان) واستراتيجيات تصنيع للغير، يمكن أن يعيد إدماج “النسيج في سوريا” ضمن سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.
اقتصاد السياسة والمنافسة: الإغراق، الطاقة، والتجارة العادلة
تواجه الصناعة النسيجية السورية حالياً ثلاثية قاسية: كلفة طاقة مرتفعة، منافسة بضائع مدعومة خارجياً، واختناقات لوجستية-مصرفية.
ترتفع تعرفة الكهرباء الصناعية محلياً إلى مستويات تفقد الشركات هامش الربح، مقارنةً بدول إقليمية تمنح أسعار طاقة أقل بكثير.
في المقابل، يدخل السوق المحلي منتجات “ستوك” ومنخفضة الجودة، بعضها عبر قنوات غير نظامية، ما يخلق حالة إغراق تضغط على الأسعار وتُربك دورة النقد.
ويقترح صناعيون إعادة تسعير الطاقة بما يقارب المستويات العالمية أو، في حدّه الأدنى، اعتماد تعويضات عبر رسوم إغراق متوازنة تعادل الدعم الذي تتمتع به السلع المستوردة في بلد المنشأ، وهو مقترح لا يهدف إلى الحماية المفرطة بقدر ما يطلب تكافؤ الفرص.
وتبرز هنا أيضاً مفارقة حدودية: في حين تفرض بعض الدول المجاورة رسوماً مرتفعة على الواردات السورية، تدخل منتجاتها بأسعار تفضيلية أو عبر ثغرات تهريب، وهو خلل في المعاملة بالمثل يستنزف “النسيج في سوريا”.
من جهة أخرى، أدت العقوبات والقيود المصرفية وغلاء الشحن إلى تعطيل قنوات التصدير، رغم وجود فرص فعلية في أسواق العراق وليبيا والأردن والخليج.
إن معالجة هذا الواقع تتطلب حزمة سياسات متكاملة: مكافحة فعلية للتهريب والتزوير، ضبط جودة المستوردات، تسهيلات تمويلية للتصدير، دعم المشاركة في المعارض، وتفعيل اتفاقيات تفضيلية مع أسواق مستهدفة.
وبدون ذلك، ستبقى قدرة “النسيج في سوريا” على استعادة مكانته رهن متغيرات خارجة عن قرار المنتج المحلي.
البيانات والاتجاهات: قراءة في المؤشرات وسيناريوهات التعافي
تُظهر البيانات المتاحة قبل 2011 مساهمة ضخمة للصناعات النسيجية في الناتج غير النفطي والتشغيل والصادرات.
لكن منذ 2011، تدحرجت المؤشرات: انخفاض حاد في القطن المحبوب والمحلوج، خروج عدد كبير من المحالج وشركات الغزل عن الخدمة، انكماش الطاقات التشغيلية، وانخفاض الطلب المحلي بفعل تدهور الدخول.
في القطاع الخاص، سجّل مسح حكومي-صناعي عام 2018 أن نحو 15% فقط من منشآت النسيج والملابس كانت قيد العمل، فيما 85% متوقفة جزئياً أو كلياً، مع تفاوت كبير بين الأنشطة.
هذا يعني أن التعافي لن يكون خطياً، بل تفاوتياً وحذراً.
في المقابل، ثمة مؤشرات تشجّع على سيناريو تعافٍ تدريجي: مرونة تاريخية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، خبرات تراكمية في إدارة الطلبات الصغيرة والمتوسطة، عودة جزئية لمنشآت بعد إعادة تأهيلها، وتوجه إلى شراكات توزيع إقليمية.
غير أن المسألة الجوهرية تظل في الحلقة الأولى: من دون برنامج واقعي لزيادة المساحات المزروعة بالقطن وتحسين جودة البذار وتخفيض كلفة الري عبر تقنيات حديثة وتحديد أسعار استلام مجزية، ستبقى بقية السلسلة مكبّلة.
كذلك يتطلب تشغيل “النسيج في سوريا” تسوية التشابكات المالية بين المؤسسات العامة، وتحديث خطوط إنتاج متقادمة، وتوفير طاقة بكلفة متوازنة.
أخيراً، يُعد غياب قاعدة بيانات حديثة مشكلة معرفية-إجرائية، إذ يعيق التخطيط ورسم السياسات.
لذا تصبح أولوية إنشاء مرصد صناعي-زراعي خاص بسلسلة النسيج والقطن ضرورة عملية لإدارة التعافي.
الابتكار، الاستدامة، والمنتجات ذات القيمة المعرفية
توجد أمام الصناعة السورية فرص استراتيجية لإعادة التموضع عبر الابتكار الأخضر والمنتجات ذات الحمولة التراثية.
أولاً، القطن العضوي والقطن الملون طبيعيّاً سوق واعدة بقيمة مضافة عالية، شريطة بناء منظومة اعتماد ومراقبة موثوقة، وتخصيص خطوط غزل ونسيج وصباغة متوافقة مع المعايير العضوية.
ثانياً، “النسيج الفني” (التقني) للاستخدامات الصناعية – فلاتر، سيور ناقلة، أقمشة عازلة، أقمشة مقاومة للماء – قطاع يتطلب تقانات أعلى لكنه يدفع الصناعة نحو شرائح سوقية أقل تقلباً وأكثر ربحية.
ثالثاً، تنشيط تربية دودة القز والحرير الطبيعي، لا سيما في البيئات المناسبة، يمكن أن يخلق منتجاً فاخراً مرتبطاً بالهوية المحلية، ويفتح باب التصدير إلى أسواق متخصصة.
رابعاً، توظيف التراث في التصميم المعاصر – من البروكار الدمشقي إلى وحدات زخرفية مستلهمة من الطراز – يمنح “النسيج في سوريا” هوية بصرية قابلة للتسويق عالمياً ويقرن المنتج بذاكرة مكان.
خامساً، التحول إلى اقتصاد تدوير مائي وطاقة شمسية في المصابغ، مع دعم حكومي عبر صندوق كفاءة الطاقة، يخفّض الكلفة ويُحسّن الامتثال البيئي.
سادساً، بناء تجمعات عنقودية (Clusters) في مدن نسيجية تقليدية، يعزّز الروابط الأفقية والعمودية بين الحِرَف والمنشآت والموردين والخدمات اللوجستية، ويقلّص كلفة المعاملات، ويزيد من مناعة “النسيج في سوريا” أمام الصدمات.
وأخيراً، لا يقل الابتكار المؤسسي أهمية عن التقني: تأسيس مراكز تطوير تصميم، مختبرات اختبار معتمدة، وحاضنات أعمال لأزياء ناشئة، كلها أدوات لتوسيع قاعدة القيمة المعرفية للقطاع.
الحوكمة والسياسات: خارطة طريق عملية
تستلزم إعادة بناء القطاع إنشاء لجنة وطنية مخوّلة برئاسة الجهة الاقتصادية العليا، تضم كل أطراف سلسلة القيمة وممثلين للغرف الصناعية وخبراء مستقلين، لتصميم برنامج زمني-مادي متكامل.
في الأجل القصير، ينبغي إزالة العوائق أمام المنشآت العاملة (الطاقة، الديون، الاستيراد والتصدير، التمويل)، وتوفير حوافز لإعادة تأهيل المتوقفة.
في الأجل المتوسط، تحديث خطوط الغزل والنسيج العامة عبر نماذج تشاركية وشفافة (BOT، شراكات، شركات مساهمة)، وتسوية التشابكات المالية التي ترفع كلفة الغزول وطنياً، وتوحيد المواصفات، ومنح تسهيلات ضريبية مشروطة بالأداء والتشغيل.
في الأجل الطويل، بناء استراتيجية صادرات تُحوِّل الإنتاج من فائض سوق محلي إلى صناعات موجهة للتصدير تستجيب لاحتياجات أسواق محددة، مع دعم ذكي مرتبط بالقيمة المضافة الفعلية.
سياسات التجارة يجب أن توازن بين الانفتاح ومنع الإغراق: إغلاق مؤقت لباب استيراد الملابس في حالات الطوارئ قد يكون أداة إسعافية، لكن الأصل هو ضبط الحدود، وتعزيز المعاملة بالمثل، وفرض مواصفات صارمة على المستوردات.
ويستلزم ذلك ربط “النسيج في سوريا” ببرامج تمويل دولية (حين تتاح)، وتطوير قدرات التخطيط والتعاون الدولي، وإطلاق مسوح دورية تُحدِّث خطط التدريب والتعليم.
هذا النظام الحوكمي لا ينجح من دون شفافية وإشراك أصحاب المصلحة الحقيقيين، والانتقال من “اللقاءات” إلى إدارة تنفيذية تتعقب مؤشرات أداء واضحة، وتربط الدعم بالنتائج.
الخلاصة: بين ترميم السلسلة واستعادة المغزى
يتبدّى من هذا العرض أن “النسيج في سوريا” ليس قطاعاً واحداً بل منظومة متعددة الحلقات والمعاني.
من رمزية السجادة والحجاب والكسوة، إلى براعة البروكار الدمشقي، إلى حِرَف أسواق دمشق وحلب وحمص، إلى منظومات القطن والحلج والغزل والنسيج والصباغة والملابس، ظل “النسيج في سوريا” ينسج خيطاً كثيفاً بين الهوية والاقتصاد.
لقد هشّمت الحرب والعقوبات والاختلالات الهيكلية حلقات السلسلة، لكن المعرفة المتراكمة والمرونة التاريخية وموقع البلد وشبكات السوق الإقليمية تمنح جميعها فرصاً واقعية لإعادة البناء.
وستظل المعادلة بسيطة في جوهرها، مركّبة في تنفيذها: من دون قطن جيد بسعر مجزٍ، وطاقة بتكلفة متوازنة، وخطوط إنتاج محدثة، وتصميم وتسويق ومواصفات، وتجارة عادلة غير مُغرِقة، لن يعود “النسيج في سوريا” كما كان.
ومن دون إحياء مهم للحرير الطبيعي والمنتجات الفنية والهوية التصميمية المعاصرة، لن يخرج “النسيج في سوريا” من منافسة مكدّسة في الشرائح الدنيا من السوق.
ومع ذلك، فإن ربط برامج التأهيل الصناعي بحفظ التراث غير المادي – عبر متاحف حية، ومناهج تدريبية للحِرَف، وتوثيق أنوال وبيوت نسيجية – يمكن أن يمنح “النسيج في سوريا” معنى اقتصادياً وثقافياً مضاعفاً، يعيد وصل ما انقطع بين الخيط والذاكرة، بين السوق والبيت، وبين الماضي الممكن والمستقبل القابل للتحقق.
بهذه الرؤية المتكاملة، يصبح “النسيج في سوريا” مشروعاً وطنياً جامعاً يوازن بين الجدوى والهوية، ويحوّل المزايا النسبية إلى تنافسية مستدامة، ويعيد كتابة قصة القماش السوري على أنوال القرن الحادي والعشرين.
الأسئلة الشائعة
- ما المقصود بمفهوم “النسيج في سوريا” بوصفه منظومة متعددة الطبقات؟
- يشير المفهوم إلى النسيج باعتباره ممارسة مادية وحرفة وفناً وصناعة ونظاماً رمزياً في آنٍ معاً. يبرز هذا التصور التداخل البنيوي بين الاقتصاد والسياسة والثقافة والدين، ويرفض الفصل الاختزالي بين الماضي كتراث والحاضر كاقتصاد محض. وفق هذا المنظور، يعيد “النسيج في سوريا” تشكيل الهوية والذاكرة وطرائق العيش عبر الزمن من خلال التجارة والسياسات العامة والتحولات الاجتماعية وحركية السوق العالمية.
- كيف يتجلى البعد الرمزي للنسيج في الميثولوجيا والأديان والفضاء الاجتماعي؟
- منذ أساطير الشرق الأدنى ظهر تشابك السدى واللحمة رمزاً للاتحاد، وتواصلت الرمزية في التقليدين المسيحي والإسلامي عبر الحجاب وستار المحراب والأقمشة الطقسية. تتجسد أمثلة بليغة في السجادة كفاصل مقدّس، والكسوة كـ”جسد” للأمكنة المقدسة، والأكفان كجسر عبور. كما شكّل القماش جزءاً تأسيسياً من أثاث البيوت الدمشقية والحلبية، بما يعكس دور “النسيج في سوريا” وسيطاً معرفياً بين المرئي والغيبي في الحياة اليومية والطقس.
- ما دلالات الانتقال من حرير البحر (البيسوس) إلى حرير دودة القز؟
- عرف الساحل السوري مبكراً حرير البحر المستخرج من أصداف Pinna nobilis بوصفه خامة نادرة وفاخرة، قبل أن تتهيأ بيئياً ومناخياً شروط ازدهار تربية دودة القز على نحو خط العرض الأربعين مع صعود الإسلام. لم يكن التبدّل مادياً فحسب، بل مسّ أنماط الإنتاج والسوق بتكثيف العمل في المشاغل واتساع الطلب الحضري، خاصة في دمشق. أسهم ذلك في تكوين طبقي-حِرَفي متنوع وترسيخ مهارات متوارثة تجلت في المصطلحات المحلية والزخارف واستعمال الخيوط الذهبية والفضية.
- ما موقع الطراز وكسوة الكعبة في البنية المؤسسية للنسيج، وكيف عبرت الأقمشة المتوسط؟
- مثّلت دور الطراز مؤسسات نسج ملحقة بالخلافة، تحوّلت فيها النقوش الكتابية إلى دعاية سياسية-دينية وعلامة جودة. باتت كسوة الكعبة ممارسة ذات دلالات سيادية تُنسج في مرافق الطراز وتتنوع ألوانها وتفاصيلها تاريخياً. عبر المتوسط، دخلت الأقمشة الإسلامية فضاء الكنائس الأوروبية كأكفان للقديسين وأثّرت في الأيقونات، مع إعادة إنتاج الخطوط العربية جمالياً. تعرض متاحف عالمية (مثل ستولا أسقف النبك في متروبوليتان) شواهد على حمل النسيج لِسرديات لاهوتية وجمالية واقتصادية.
- كيف أسهم طريق الحرير في تشكيل الهوية النسيجية السورية؟
- أدت سوريا دور محطة وسيطة لتدفقات البضائع والتقنيات والأفكار، فامتزجت مهارات الحرفيين بمؤثرات شرقية وغربية لتنتج أقمشة بهوية سورية متفردة. أعاد الطريق صوغ البنى المهنية وتقاليد الزخرفة وذائقة الألوان ونظم القياس. دلّت اكتشافات تدمر (أكثر من 2000 قطعة حرير من العصر الروماني-الشرقي) وأسواق دمشق وحلب على أن “النسيج في سوريا” يتجاوز ثنائية تراث/صناعة ليكون نمط عيش واقتصاد هدايا وسياحة، قبل أن تتأثر الذائقة والطلب بالتحولات الأخيرة.
- ما التحول البنيوي الذي أحدثه القطن في القرن العشرين، وما آثاره بعد 2011؟
- انتقل ثقل الصناعة من الحرير إلى القطن مع توسع الزراعة، وأسهمت الصناعات النسيجية قبل الأزمة بنحو 27% من صافي الناتج الصناعي غير النفطي، وحوالي 45% من الصادرات غير النفطية، وبنحو 30% من العمالة الصناعية، مع قرابة 24 ألف منشأة رسمية. بعد 2011، هبطت كميات القطن المستلمة رسمياً من نحو 628 ألف طن (2010) إلى أقل من 20 ألف طن (2021)، ما عطّل الحلج والغزل وانعكس على النسيج والملابس. يبرز من ذلك أن استعادة التوازن تمر عبر إصلاح الحلقة الزراعية-الصناعية معاً.
- ما هي حلقات سلسلة القيمة في النسيج السوري وأين تتواجد الاختناقات؟
- تتألف السلسلة من: الزراعة (القطن)، الحلج، الغزل، النسيج، الصباغة/التحضير/الطباعة، التصميم، والملابس الجاهزة، مع لوجستيات وتمويل وتسويق. تشمل الاختناقات تقلب المساحات وكلفة المستلزمات وجودة البذار وأساليب الري والقطاف؛ تدني جودة القطن المحبوب وتعطل المحالج؛ قدم خطوط الغزل وارتفاع كلفة الطاقة ونقص الكفاءات؛ عدم استقرار توريد الغزول واتساع التهريب؛ كلفة الأصبغة والمياه ومتطلبات الامتثال البيئي؛ ضعف الاستثمار في التصميم؛ واختناقات التصدير والتمويل والمعايير في الجاهزة.
- أين تتبلور القيمة المضافة الأعلى وكيف يمكن تعظيمها؟
- تتكثف القيمة المضافة في الإنهاء الجيد (الصباغة والتحضير) والتصميم والتسويق. يقتضي ذلك التحول إلى أصبغة صديقة للبيئة، وإعادة تدوير المياه، واستثمارات في تقانات نظيفة ومحطات معالجة مركزية. أكاديمياً، يتطلب سدّ فجوة التصميم إنشاء برامج تطبيقية وشراكات مع بيوت تصميم، وتطوير هويات علامات. كما يعزّز الاعتماد على شهادات المطابقة، والتغليف، والتجارة الإلكترونية، وربط المراكز الصناعية بمستودعات إقليمية واستراتيجيات التصنيع للغير القدرة على الاندماج في سلاسل القيمة.
- ما أبرز تحديات الاقتصاد السياسي والمنافسة وأدوات معالجتها؟
- تواجه الصناعة تعرفة طاقة مرتفعة مقارنةً بإقليم يمنح أسعاراً أدنى، وإغراقاً بمنتجات ستوك ومنخفضة الجودة غالباً عبر قنوات غير نظامية، إلى جانب قيود مصرفية وشحن. تقترح المقالة إعادة تسعير الطاقة أو اعتماد رسوم مكافحة إغراق تعادل الدعم الخارجي، وتعزيز المعاملة بالمثل على الحدود. كما توصي بمكافحة التهريب والتزوير، وضبط جودة المستوردات، وتسهيلات تمويلية للتصدير، ودعم المشاركة في المعارض، وتفعيل اتفاقيات تفضيلية مع أسواق مستهدفة.
- ما متطلبات التعافي والحوكمة الفعّالة لإعادة بناء القطاع؟
- توصي المقالة بلجنة وطنية تضم أطراف السلسلة والغرف الصناعية وخبراء مستقلين لتصميم برنامج زمني متكامل. قصير الأجل: إزالة العوائق أمام المنشآت العاملة (الطاقة، الديون، التجارة، التمويل). متوسط الأجل: تحديث خطوط الغزل والنسيج العامة عبر نماذج تشاركية شفافة (BOT وشراكات)، وتسوية التشابكات المالية وتوحيد المواصفات وحوافز ضريبية مرتبطة بالأداء. طويل الأجل: استراتيجية صادرات موجهة للسوق الدولي، مع إنشاء مرصد صناعي-زراعي لسلسلة النسيج والقطن، وبناء تجمعات عنقودية، واعتماد حوكمة شفافة تربط الدعم بالنتائج، وربط التعافي بحفظ التراث غير المادي عبر متاحف حية ومناهج تدريبية وتوثيق تقنيات الأنوال.