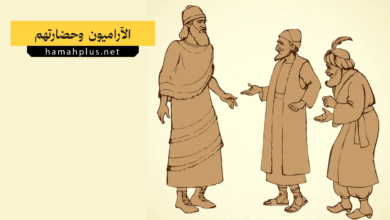حماة في زمن الانتداب الفرنسي: مقاومة وثورات وطنية

محتوى المقالة
I. مقدمة: حماة في سياق الانتداب الفرنسي
1.1. فرض الانتداب الفرنسي على سوريا: سياق ما بعد الحرب العالمية الأولى
بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى في عام 1918، دخلت قوات الثورة العربية دمشق وأسست حكومة عربية سعت لتحقيق الاستقلال. إلا أن هذا الحكم الوطني الوليد قوبل بالرفض من قبل الحلفاء، مما مهد الطريق لفرض الانتداب الأجنبي على المنطقة. تأكد هذا الفرض بموجب اتفاقية سايكس بيكو ومؤتمر سان ريمو الذي عُقد عام 1920، والذي قسم بلاد الشام إلى مناطق نفوذ بين القوى الاستعمارية.
في تموز 1920، وجه الجنرال الفرنسي غورو إنذاراً نهائياً إلى الحكومة العربية في دمشق، مطالباً بحل الجيش السوري وقبول الانتداب والعملة الفرنسية، وكان الهدف الواضح من هذا الإنذار هو القضاء على أي حركة وطنية ناشئة في سوريا. توجت هذه الأحداث بمعركة ميسلون في 24 تموز 1920، حيث قاوم وزير الحربية يوسف العظمة ببسالة، لكن الهزيمة أدت إلى احتلال الجيش الفرنسي لدمشق في اليوم التالي، وبذلك بدأ واقع الانتداب الفرنسي على سوريا.
تجدر الإشارة إلى أن القوى الحليفة، بما فيها فرنسا، كانت قد أذاعت خلال الحرب العالمية الأولى مبادئ احترام القوميات وتحرير الشعوب وحقها في تقرير مصيرها، وذلك لتشجيع الثورات ضد الدولة العثمانية. ومع ذلك، فإن الفترة التي أعقبت الحرب مباشرة شهدت تناقضاً صارخاً؛ فبدلاً من منح الاستقلال الموعود، فرضت هذه القوى الانتدابات وقمعت الحكومات العربية الناشئة بعنف، كما يتضح من الإنذار الفرنسي لحكومة الملك فيصل ومعركة ميسلون. هذا التناقض الجوهري بين الوعود والواقع، والإنكار المباشر لحق تقرير المصير، عمل كعامل محفز عميق، محولاً الآمال الأولية بالتحرر إلى استياء عميق وموجة واسعة من المقاومة الوطنية عبر سوريا، بما في ذلك حماة.
1.2. السياسات الفرنسية وتأثيرها على الأوضاع السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية في حماة
اتسمت إدارة الانتداب الفرنسي في سوريا بسياسة مركزية وتدخلية، حيث عملت على شرذمة البلاد سياسياً وإقامة كيانات وإدارات على أسس طائفية أو إثنية. كانت حماة جزءاً من “الدولة السورية” التي تشكلت عام 1924. هذا التقسيم أدى إلى إعاقة قيام إدارة حكومية فعالة واقتصاد وطني موحد.
على الصعيد الاقتصادي، صُممت التجارة والنظام المصرفي لخدمة مصالح الإمبراطورية الفرنسية، غالباً على حساب المصلحة السورية. أهملت سلطات الانتداب حماية الصناعات المحلية الناشئة والقطاع الزراعي، الذي كان يشكل الشريان الاقتصادي الأهم في البلاد. فُرضت ضرائب باهظة على الفلاحين، مما أفقدهم القدرة على تسديد ديونهم ودفعهم إلى الهجرة، وهو ما أدى إلى تدهور الزراعة وتناقص وارداتها.
على المستوى العسكري والأمني، ألغت فرنسا نظام التجنيد الإجباري وسرحت الجيش العربي، وفرضت غرامات حربية، واحتلت محطات السكك الحديدية في المدن الرئيسية بما فيها حماة. كما مولت أجهزتها الأمنية والعسكرية بضرائب محلية عالية جداً، تجاوزت بأربعة إلى سبعة أضعاف ما كانت تفرضه في المستعمرات الفرنسية الأخرى.
أما التأثير الاجتماعي والثقافي، فقد مارست فرنسا سياسة خنق الحريات، ومنعت تأسيس الأحزاب، وطاردت الوطنيين، وأكثرت من اعتقالهم ونفيهم. وتدخلت في جوانب الحياة الاجتماعية، مثل منع ارتداء الملابس الوطنية، وتقييد حركة المواطنين، وتشجيع هجرات عناصر أجنبية، وحتى تشجيع بيوت الدعارة. كما أدت سياسات التعليم إلى تفاوتات حادة بين أبناء الشعب الواحد، مما خلف شعوراً بالاغتراب بينهم.
تجاوزت سياسات الانتداب الفرنسي مجرد الحكم السياسي؛ فقد شكلت هندسة متعمدة ومتعددة الأوجه للمجتمع والاقتصاد السوري. كان الهدف من تجزئة سوريا هو تفكيك أي هوية وطنية موحدة، بينما صُممت السياسات الاقتصادية لاستنزاف الموارد بشكل منهجي وخلق سوق أسيرة للمنتجات الفرنسية، مما خنق التنمية المحلية. علاوة على ذلك، هدفت التدخلات الاجتماعية والثقافية ، من التحكم في اللباس إلى تشجيع سلوكيات معينة، إلى تآكل التقاليد المحلية وقمع الوعي الوطني. هذا النهج المتكامل يعكس طموحاً استعمارياً عميقاً ليس فقط للحكم، بل لإعادة تشكيل المجتمع المستعمر جذرياً لخدمة المصالح الإمبراطورية، مما أدى إلى استياء واسع وعميق غذى المقاومة الشاملة.
إن فرض الضرائب الباهظة على الزراعة والإهمال المتعمد للصناعات المحلية أدى بشكل مباشر إلى شل العمود الفقري الاقتصادي للمجتمع السوري، مما أثر بشكل خاص على السكان الريفيين والطبقات العاملة. هذا الاستغلال الاقتصادي، إلى جانب قمع الحريات المدنية والتدخل الثقافي ، خلق شعوراً منتشراً بالظلم والمشقة في جميع طبقات المجتمع. هذا الارتباط يوضح علاقة سببية واضحة حيث لم تكن السياسات الاقتصادية الاستغلالية والاجتماعية القمعية للانتداب مجرد عوامل خلفية، بل كانت محركات مباشرة وقوية أشعلت وأبقت على الانتفاضات الشعبية، بما في ذلك تلك التي شهدتها حماة.
II. أشكال المقاومة الوطنية في حماة
2.1. المقاومة المسلحة: طبيعتها وأبرز أحداثها
برزت حماة كمركز للمقاومة المسلحة ضد القوات الفرنسية، حيث حمل أبناؤها السلاح وشاركوا بفعالية في الثورة السورية الكبرى عام 1925. شهدت المدينة هجمات مباشرة على المنشآت الأمنية الفرنسية، مما أظهر قدرة المقاومين على المواجهة العسكرية. في مرحلة لاحقة من الانتداب، وتحديداً في عام 1945، قاد الضابط الحموي الشاب أديب الشيشكلي عصياناً مسلحاً ضد القوات الفرنسية بعد انشقاقه عنها، مما يؤكد استمرارية وتجذر المقاومة المسلحة في حماة عبر الزمن.
لم تكن المقاومة المسلحة في حماة حدثاً منفرداً يقتصر على انتفاضة 1925؛ بل تجلت كظاهرة مستمرة ومتطورة طوال فترة الانتداب، وبرزت بشكل ملحوظ مع تمرد أديب الشيشكلي المسلح عام 1945. هذا النمط يشير إلى أن المواجهة العسكرية كانت استجابة راسخة ومستمرة للاحتلال، تتكيف مع التغيرات السياسية والقيادية، وتعكس التزاماً مستداماً من قبل أهالي حماة بتحقيق التحرير من خلال الكفاح المسلح عندما تثبت الوسائل الأخرى عدم كفايتها.
2.2. المقاومة السياسية والمدنية: الاحتجاجات، الإضرابات، ودور الجمعيات الوطنية
تجاوزت المقاومة في حماة العمل المسلح لتشمل أشكالاً سياسية ومدنية واسعة. كانت حماة جزءاً من المدن السورية التي شهدت مظاهرات واحتجاجات متزايدة وإضرابات عامة ضد الانتداب الفرنسي. الإضراب الستيني الذي حصل في سوريا عام 1936، والذي دعت إليه الكتلة الوطنية، شمل حماة وكان أطول إضراب في تاريخ سوريا، ووصفته الصحافة العالمية بأنه “أروع عمل سلبي ضد المحتل الغاصب”.
بعد أن سمح المفوض الفرنسي بإنشاء الجمعيات والأحزاب السياسية في شباط 1925، تأسست “الكتلة الوطنية” التي ضمت قادة وطنيين بارزين. ورغم أن شعبية الكتلة الوطنية كانت تتركز في دمشق، إلا أن حماة وحمص وحلب كانت من أنصار “حزب الشعب”، مما يشير إلى تنوع الولاءات السياسية المحلية ضمن الحركة الوطنية. شاركت النخبة السياسية الحموية، مثل الصحفي والسياسي نجيب الريس والشيخ محمد الحامد، بفعالية في الكفاح السياسي.
كما أظهر وجهاء حماة اهتماماً بتطوير اقتصاد وطني ليكون أحد الدعائم الأساسية لاستقلال البلاد. في عام 1929، استثمر وجهاء محليون لإنشاء “شركة حمص وحماة للكهرباء”، وتم مد الكهرباء إلى حماة عام 1930. ونجحت شركات النقل الوطنية في كسر احتكار “شركة دمشق-حماة للخطوط الحديدية” الفرنسية، التي اضطرت لطلب الدعم المالي الحكومي من دافعي الضرائب السوريين أنفسهم. هذه المبادرات تعكس مقاومة اقتصادية منظمة وهادفة.
شهدت حماة أيضاً ظهور صحف يومية وطنية مثل “حماة”، “نهر العاصي”، “التوفيق”، “الإخاء”، “الهدف”، و”الشعب”، مما يدل على وجود صوت إعلامي وطني حيوي يسهم في تعبئة الرأي العام وتوجيهه.
توضح الأدلة بوضوح أن المقاومة في حماة لم تقتصر على المواجهة المسلحة فحسب، بل شملت استراتيجية متطورة ومتعددة الأوجه تضمنت أبعاداً سياسية ومدنية واقتصادية. أدت الإضرابات العامة الواسعة النطاق إلى شل الوظائف الاقتصادية والإدارية للانتداب، مظهرة قوة العصيان المدني اللاعنفي. بالتوازي، مثلت المبادرات الاقتصادية الوطنية، مثل تأسيس شركة حمص وحماة للكهرباء وكسر الاحتكارات الفرنسية، تحدياً اقتصادياً مباشراً يهدف إلى بناء الاكتفاء الذاتي وتقويض السيطرة الاستعمارية. علاوة على ذلك، عملت الصحافة الوطنية الناشئة كمنصة حاسمة لنشر الأفكار المناهضة للاستعمار وتعبئة الدعم الشعبي. هذا النهج الشامل يؤكد وجود حركة وطنية ناضجة أدركت ضرورة مواجهة المحتل على جبهات متعددة، مما يعكس فهماً استراتيجياً أعمق يتجاوز مجرد التكتيكات العسكرية.
تُظهر المصادر علاقة دقيقة بين النخب التقليدية في حماة (مثل ملاك الأراضي والوجهاء) وعموم السكان (الفلاحين والعمال) في حركة المقاومة. فبينما سعت السياسة الفرنسية في بعض الأحيان لاستمالة الوجهاء لتقويض المقاومة الوطنية ، فإن حالة حماة تكشف واقعاً أكثر تعقيداً. شخصيات مثل محمود البرازي ونجيب آغا البرازي، من عائلات إقطاعية بارزة ، دعموا المقاومة وقادوها بنشاط، وقدموا الموارد المالية الحيوية وأماكن الاجتماعات.
في الوقت نفسه، انخرط مثقفون مثل الدكتور توفيق الشيشكلي وصحفيون مثل منير الريس في المقاومة السياسية والمدنية. يشير هذا إلى أن القيادة الوطنية في حماة لم تكن أحادية، بل تشكلت من ائتلاف متنوع يضم نخب تقليدية، وشخصيات عسكرية، ونشطاء فكريين وسياسيين. كانت هذه القيادة متعددة المستويات حاسمة في تعبئة شرائح مختلفة من المجتمع والحفاظ على أشكال متنوعة من المقاومة، مما يبرز دينامية داخلية عززت الجبهة المناهضة للاستعمار.
III. انتفاضة حماة الكبرى عام 1925: تحليل شامل
3.1. الأسباب المباشرة وغير المباشرة لاندلاع الانتفاضة
كانت انتفاضة حماة جزءاً لا يتجزأ من الثورة السورية الكبرى، التي اندلعت نتيجة رفض السوريين للاحتلال الفرنسي وسعيهم لتحقيق الاستقلال التام. ساهمت السياسات الفرنسية التي مزقت سوريا إلى دويلات صغيرة، وتعسف السلطات الفرنسية في قمع الحركات الوطنية، ومنع تأسيس الأحزاب وملاحقة الوطنيين، في تأجيج الغضب الشعبي على نطاق واسع.
على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، أدت السياسات الفرنسية إلى تدهور الزراعة والتجارة، وفرض الضرائب الباهظة، مما زاد من السخط الشعبي. كما أن التدخلات الفرنسية في الحياة الاجتماعية والثقافية، مثل إثارة النعرات الطائفية ومنع ارتداء الملابس الوطنية، أثارت غضباً واسعاً بين السكان.
أما على الصعيد المحلي في حماة، فقد شهدت المدينة تعاطفاً شعبياً عاماً مع الثوار. بالإضافة إلى ذلك، كان النشاط السري الذي قام به فوزي القاوقجي في حماة للتحضير للثورة عاملاً مباشراً في تفجير الانتفاضة.
لم تكن انتفاضة حماة عام 1925 حدثاً معزولاً، بل كانت نتيجة مباشرة لتراكم المظالم الوطنية ضد الانتداب الفرنسي، بما في ذلك التجزئة السياسية، والاستغلال الاقتصادي، والقمع الاجتماعي. ومع ذلك، فإن التوقيت المحدد وشدة الانتفاضة في حماة كانا مدفوعين بعوامل محلية حاسمة، مثل التعاطف الشعبي الواسع النطاق داخل المدينة والجهود التنظيمية السرية لفوزي القاوقجي. هذا يوضح أنه بينما خلقت السياسات الوطنية أرضاً خصبة للثورة، كانت القيادة المحلية واستعداد المجتمع ضروريين لتحويل السخط العام إلى انتفاضة مسلحة نشطة.
3.2. التسلسل الزمني للأحداث الرئيسية للانتفاضة
أُعلنت انتفاضة حماة في الرابع من تشرين الثاني عام 1925، بقيادة فوزي القاوقجي. في المراحل الأولية، نجح المنتفضون في الاستيلاء على مخافر الدرك وفتح أبواب السجن، مما أدى إلى إطلاق سراح أكثر من خمسمئة سجين.
رداً على هذه الهزائم الأولية، قامت القوات الفرنسية بقصف مدينة حماة بالمدفعية والطائرات، وأعلنت الأحكام العرفية ومنع التجول. وصلت تعزيزات عسكرية فرنسية، بقيادة الجنرال غاملان، مما أجبر فوزي القاوقجي على الانسحاب من حماة. في أعقاب ذلك، فرضت فرنسا غرامات حربية على أهالي حماة وسجنت كبار أعيان المدينة، مما أدى إلى انتهاء الانتفاضة. تشير المصادر الفرنسية إلى مقتل 76 من الثوار، بينما بلغت حصيلة الضحايا المدنيين 344 قتيلاً.
كان استهداف الثوار الفوري والناجح لمراكز الدرك والسجون ليس مجرد انتصار تكتيكي، بل كان عملاً رمزياً للغاية. مثلت هذه المؤسسات الأدوات المباشرة للسلطة والقمع الفرنسيين. من خلال الاستيلاء عليها وتحرير مئات السجناء، أظهر الثوار تحولاً دراماتيكياً ومؤقتاً في موازين القوى، موجهين رسالة قوية من التحدي والتحرر إلى السكان. هذا النجاح الأولي، على الرغم من قصره، عمل كدفعة معنوية قوية وإعلان واضح للنوايا، مما حشد المزيد من الدعم الشعبي وأشار إلى الانفجار الرسمي للانتفاضة.
3.3. النتائج والآثار المترتبة على الانتفاضة
على الرغم من قمعها، كان لانتفاضة حماة عام 1925 أثر استراتيجي كبير على الثورة السورية الكبرى الأوسع نطاقاً. أدت الانتفاضة إلى انسحاب القوات الفرنسية بقيادة الجنرال غاملان من منطقة جبل الدروز وتوجهها إلى حماة للقضاء على الانتفاضة. هذا التحويل للقوات خفف الضغط على الثوار في جبل الدروز وساعد على انتشار الثورة إلى مناطق أخرى في سوريا، مثل الغوطة وإقليم البلان والقلمون.
على الصعيد الوطني، أدت الانتفاضة، رغم قمعها، إلى زيادة إقبال المتطوعين من المناطق السورية المختلفة للمشاركة في الثورة، مما يعكس انتشار الوعي وتوحيد الجهود على مستوى وطني. كما أنها ألحقت ضربة قاصمة بسمعة فرنسا، وكشفت وحشية سياستها. ساهمت الانتفاضة أيضاً في تعاظم الشعور الوطني في حماة، خاصة بين الفئة المثقفة المناهضة للانتداب.
على الرغم من قمع انتفاضة حماة عسكرياً من قبل الفرنسيين، مما أدى إلى سقوط ضحايا وإعادة فرض السيطرة ، فإن عواقبها طويلة الأمد تجاوزت الهزيمة العسكرية. فقد عززت الانتفاضة بشكل كبير الروح الوطنية، وشجعت المزيد من المتطوعين من جميع أنحاء سوريا، وعززت تنظيم الحركة الثورية. علاوة على ذلك، أضرت بسمعة فرنسا بشدة، كاشفةً وحشية انتدابها. هذا يوضح ديناميكية حاسمة في الصراعات المناهضة للاستعمار: حتى النكسات العسكرية يمكن أن تتحول إلى انتصارات سياسية ومعنوية عميقة، مما يحشد الدعم الشعبي ويعمق الوعي القومي، وبالتالي يمهد الطريق لمقاومة مستقبلية أكثر استدامة.
IV. قادة المقاومة الوطنيون من حماة
4.1. الدور المحوري لفوزي القاوقجي في قيادة الانتفاضة
كان فوزي القاوقجي القائد الرئيسي لانتفاضة حماة التي أُعلنت في 4 تشرين الثاني 1925. ولد القاوقجي في طرابلس عام 1890 وتخرج ضابطاً من الكلية الحربية في إسطنبول عام 1912، مما منحه خبرة عسكرية قيمة في التخطيط والتنفيذ.
بعد انسحابه من حماة، لم يتوقف القاوقجي عن النضال، بل بقي متنقلاً بين حماة والغوطة والقلمون لمدة ثلاث سنوات، خاض خلالها عشرات المعارك وكبد الفرنسيين خسائر فادحة. كان هدفه من هذه التحركات المستمرة هو تخفيف الضغط على الثوار في جنوب سوريا، مما يدل على فهمه العميق للتنسيق الاستراتيجي بين جبهات المقاومة المختلفة. كان القاوقجي شخصية قومية عربية بارزة، ناضل في ميادين مختلفة من سوريا إلى العراق وحتى فلسطين، مما يؤكد التزامه بالقضية العربية الأوسع.
إن خلفية فوزي القاوقجي كضابط عسكري مدرب من العهد العثماني وفرت عنصراً حاسماً من القيادة الاحترافية لانتفاضة حماة الشعبية إلى حد كبير. من المرجح أن خبرته ساهمت في النجاحات الأولية للثوار في الاستيلاء على مراكز الدرك والسجون. علاوة على ذلك، فإن تحركاته الاستراتيجية المستمرة واشتباكاته عبر مناطق مختلفة بعد انتفاضة حماة تظهر فهماً متطوراً لحرب العصابات والتنسيق بين الجبهات، وهو ما كان حيوياً للحفاظ على الضغط على الفرنسيين وتخفيف العبء عن مناطق الثوار الأخرى. هذا يسلط الضوء على كيف أن دمج المهارات العسكرية الاحترافية مع الحماس الشعبي يمكن أن يعزز بشكل كبير فعالية وتأثير الحركات المقاومة الاستراتيجية.
4.2. شخصيات حموية بارزة أخرى في الحركة الوطنية
إلى جانب فوزي القاوقجي، برزت عدة شخصيات حموية أخرى لعبت أدواراً محورية في الحركة الوطنية والمقاومة ضد الانتداب الفرنسي:
- محمود البرازي: كان من وجهاء حماة، ولد عام 1850، وقاوم الاحتلال التركي ثم الفرنسي. استضاف الملك فيصل في منزله عام 1919، الذي أصبح مركزاً لاجتماعات وجهاء المدينة مع الملك، مما يؤكد مكانته ونفوذه. دعم محمود البرازي الثوار بالمال والسلاح في ثورة 1925، ونتيجة لذلك، ورغم كبر سنه، وُضع تحت الإقامة الجبرية والمراقبة من قبل سلطات الانتداب.
- نجيب آغا البرازي: سياسي واقتصادي مخضرم من حماة، ظهر كأحد أعيان المدينة في قيادة الحركة الوطنية السورية خلال الثورة السورية الكبرى عام 1925. كانت مضافته في حي البرازية بحماة مركزاً كبيراً وشهيراً لتجمع الوطنيين، مما يؤكد دوره في التعبئة والتنظيم.
- الدكتور توفيق الشيشكلي: زعيم وطني وأديب سياسي من حماة، لعب دوراً في قيادة الحركة الوطنية السورية خلال ثورة 1925.
- أديب الشيشكلي: ضابط حموي شاب، انشق عن الفرنسيين وقاد عصياناً مسلحاً في حماة عام 1945، وكان له دور لاحق في تأسيس الجيش السوري والانقلابات بعد الاستقلال.
- قادة آخرون: شملت قائمة القادة الحمويين البارزين في الثورة السورية الكبرى أيضاً سعيد العاص، وجميل العلواني، ومنير الريس. كما شارك نجيب الريس، الصحفي والسياسي المعروف، والشيخ محمد الحامد من النخبة الحموية في الكفاح السياسي.
بينما سعت السياسة الفرنسية في كثير من الأحيان إلى استمالة الوجهاء المحليين لتقويض المقاومة الوطنية ، فإن حالة حماة تظهر واقعاً أكثر تعقيداً. فقد دعم شخصيات مثل محمود البرازي ونجيب آغا البرازي، وهما من عائلات إقطاعية بارزة ، المقاومة وقادوها بنشاط، وقدموا المساعدات المالية وأماكن الاجتماعات. في الوقت نفسه، انخرط مثقفون مثل الدكتور توفيق الشيشكلي وصحفيون مثل منير الريس في المقاومة السياسية والمدنية.
هذا يشير إلى أن القيادة الوطنية في حماة لم تكن أحادية، بل كانت تتألف من ائتلاف متنوع من النخب التقليدية، والشخصيات العسكرية، والنشطاء الفكريين والسياسيين. هذه القيادة متعددة المستويات كانت حاسمة في تعبئة شرائح مختلفة من المجتمع والحفاظ على أشكال متنوعة من المقاومة، مما يبرز دينامية داخلية عززت الجبهة المناهضة للاستعمار.
4.3. تأثير هؤلاء القادة على مسار النضال الوطني
لعب هؤلاء القادة دوراً حاسماً في تنظيم وتوجيه المقاومة في حماة، سواء في العمليات المسلحة أو في الكفاح السياسي والمدني. لقد وفروا الدعم المالي واللوجستي الضروري للثوار، مستغلين نفوذهم ومواردهم. كما شكلوا رموزاً وطنية ألهمت الشعب الحموي والسوري الأوسع للمضي قدماً في مقارعة الاستعمار، مما ساهم في تعزيز الوعي القومي.
تضاعفت فعالية مقاومة حماة بشكل كبير بفضل وجود قادة محليين أقوياء. هؤلاء الشخصيات، التي كانت متجذرة بعمق في النسيج الاجتماعي (على سبيل المثال، من خلال شبكات العائلات مثل مضافة آل البرازي )، تمكنت من ترجمة المثل العليا المجردة للاستقلال الوطني إلى دعوات ملموسة للعمل تلقى صدى لدى السكان. كانت قدرتهم على تعبئة الموارد ، وتنظيم الأنشطة السرية ، وتقديم القيادة المباشرة أساسية في تحويل السخط الواسع إلى مقاومة منظمة ومستدامة. هذا يسلط الضوء على الدور الحاسم للقيادة المحلية في سد الفجوة بين التطلعات الوطنية والتعبئة الشعبية على مستوى القاعدة، مما جعلهم لا غنى عنهم للنجاح الشامل للحركة المناهضة للاستعمار.
V. حماة ضمن الثورة السورية الكبرى
5.1. أهمية مشاركة حماة في الثورة السورية الكبرى
كانت الثورة السورية الكبرى عام 1925 أكبر وأطول تمرد ضد الاستعمار في المشرق العربي بين الحربين العالميتين. تميزت الثورة بتعبئة واسعة للفلاحين والعمال وقدامى المحاربين، ولم تقتصر على النخب الحضرية والمثقفين الوطنيين فقط، مما جعلها أول حركة جماهيرية ضد الحكم الاستعماري في الشرق الأوسط.
امتدت الثورة من جبل الدروز، حيث بدأت، لتشمل دمشق وحلب وحماة وحمص وأجزاء أخرى من سوريا، مما يدل على اتساع نطاقها وتأثيرها على مستوى البلاد. كانت مشاركة حماة ذات أهمية استراتيجية بالغة، حيث أدت انتفاضتها إلى انسحاب القوات الفرنسية بقيادة الجنرال غاملان من منطقة جبل الدروز وتوجهها إلى حماة للقضاء على الانتفاضة. هذا التحويل للقوات خفف الضغط على الثوار في جبل الدروز وسمح لهم بتعزيز مواقعهم، مما يؤكد الدور الحيوي لحماة في دعم الجبهات الأخرى للثورة.
لم تكن مشاركة حماة النشطة في الثورة السورية الكبرى مجرد عمل تحدٍ محلي، بل كانت مساهمة حاسمة واستراتيجية في النضال الوطني الأوسع. حقيقة أن انتفاضتها أجبرت الجيش الفرنسي على إعادة نشر قوات كبيرة، بما في ذلك تلك التي كانت تحت قيادة الجنرال غاملان، من منطقة جبل الدروز تظهر قدرة حماة على العمل كنقطة ضغط حيوية. هذا التحويل للموارد وفر فرصة حيوية لجبهات الثوار الأخرى، مما سمح لهم بإعادة التجمع ومواصلة قتالهم. هذا يسلط الضوء على دور حماة كعقدة لا غنى عنها في الشبكة المترابطة للمقاومة السورية، قادرة على التأثير بشكل مباشر على الديناميكيات الاستراتيجية للحركة المناهضة للاستعمار بأكملها.
5.2. مقارنة مقاومة حماة بمدن سورية أخرى
قبل اندلاع الثورة السورية الكبرى، شهدت سوريا حوالي 35 ثورة محلية متفرقة، مما يشير إلى غياب القيادة الموحدة في البدايات. كانت دمشق وحمص وحلب وحماة مراكز رئيسية للمقاومة ضد الانتداب الفرنسي. ومع ذلك، تباينت أشكال المقاومة والولاءات السياسية بين هذه المدن.
على سبيل المثال، كانت شعبية الكتلة الوطنية، التي قادت الكفاح السياسي، تتركز بشكل أكبر في دمشق ودرعا والقنيطرة والسويداء. في المقابل، كانت حلب وحمص وحماة من أنصار “حزب الشعب”. هذا التباين يعكس ديناميكيات محلية مختلفة وتفضيلات سياسية متنوعة ضمن الحركة الوطنية الأوسع.
بينما وحد هدف الاستقلال المدن السورية، تكشف المصادر عن تنوع كبير في أشكال المقاومة والولاءات السياسية عبر المناطق المختلفة. فانتفاضة حماة المسلحة القوية في عام 1925 ودعمها لحزب الشعب يتناقضان مع دمشق، التي كانت معقلاً للكتلة الوطنية وغالباً ما انخرطت في أشكال مقاومة سياسية ومدنية أكثر. هذا التنوع الإقليمي يشير إلى أن الثورة السورية الكبرى لم تكن حركة موحدة مركزياً، بل كانت صراعاً لا مركزياً ولكنه مترابط، حيث ساهمت كل مدينة من خلال نقاط قوتها الفريدة، وقيادتها المحلية، وسياقها الاجتماعي والسياسي الخاص. هذا يسلط الضوء على الطبيعة العضوية والتكيفية للحركة الوطنية.
5.3. آليات التنسيق والترابط بين حركات المقاومة المختلفة
أظهرت تحركات فوزي القاوقجي بعد انسحابه من حماة، حيث بقي متنقلاً بين حماة والغوطة والقلمون بهدف تخفيف الضغط على الثوار في جنوب سوريا، وجود تنسيق عملي بين الجبهات الثورية المختلفة. هذا التنسيق يشير إلى شبكة مقاومة مترابطة تتجاوز الحدود الإدارية التي فرضها الانتداب.
أدت الانتفاضة في حماة إلى زيادة إقبال المتطوعين من مناطق سورية مختلفة، مما يعكس انتشار الوعي الوطني وتوحيد الجهود على مستوى وطني. كما دعت البيانات الصادرة عن الثوار إلى وحدة البلاد السورية بساحلها وداخلها، والاعتراف بدولة سورية عربية واحدة مستقلة استقلالاً تاماً، ورفض التقسيمات المحلية التي فرضها الانتداب، مما يؤكد الهدف المشترك لوحدة الأراضي السورية.
إن قدرة قادة مثل فوزي القاوقجي على العمل عبر جبهات جغرافية متعددة (حماة، الغوطة، القلمون) بهدف صريح هو تخفيف الضغط على مناطق الثوار الأخرى تشير إلى مستوى حاسم، وإن كان غير رسمي، من التنسيق العملياتي بين مجموعات المقاومة المتباينة. هذا التنسيق العملي، بالإضافة إلى الدعوات الأيديولوجية القوية للوحدة السورية التي تحدت بشكل مباشر سياسة “فرق تسد” الفرنسية، يوضح كيف عملت الحركة الوطنية بنشاط للتغلب على الانقسامات المصطنعة التي فرضها الانتداب. كان هذا الترابط الاستراتيجي حيوياً للحفاظ على الثورة السورية الكبرى بمرور الوقت وعبر مناطق متنوعة، مما ساهم في النهاية في الهدف طويل الأمد المتمثل في سوريا موحدة ومستقلة.
VI. الخلاصة والدروس المستفادة
6.1. تلخيص لأبرز مساهمات حماة في مقاومة الانتداب
برزت حماة كمركز حيوي للمقاومة الوطنية ضد الانتداب الفرنسي، حيث لم تقتصر مساهماتها على الجانب العسكري فحسب، بل شملت أيضاً أشكالاً متنوعة من المقاومة المدنية والسياسية والاقتصادية. كانت انتفاضة حماة عام 1925 حدثاً محورياً ضمن الثورة السورية الكبرى، حيث أظهرت قدرة المدينة على التعبئة والتضحية، وكان لها أثر استراتيجي في تخفيف الضغط على جبهات أخرى للثورة. قدمت حماة كوكبة من القادة الوطنيين البارزين، مثل فوزي القاوقجي، ومحمود البرازي، ونجيب آغا البرازي، والدكتور توفيق الشيشكلي، الذين لعبوا أدواراً محورية في قيادة النضال وتنظيمه، سواء على الصعيد العسكري أو السياسي أو الاجتماعي.
6.2. الدروس التاريخية المستخلصة من تجربة المقاومة في حماة
تؤكد تجربة حماة في مقاومة الانتداب الفرنسي عدة دروس تاريخية عميقة:
- مرونة المقاومة في مواجهة القمع: تُظهر تجربة حماة أن المقاومة الوطنية ليست ظاهرة ثابتة، بل تتسم بالمرونة والقدرة على التكيف. ففي مواجهة القمع العسكري الفرنسي الشديد، تطورت أشكال المقاومة لتشمل الإضرابات العامة، والمبادرات الاقتصادية الوطنية الهادفة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، والعمل الصحفي التعبوي. هذا يدل على أن إرادة الشعب في الاستقلال لا يمكن كبتها بشكل دائم، بل تجد سبلاً جديدة ومتنوعة للتعبير عن نفسها، مما يضمن استمرارية النضال.
- تحويل الهزائم العسكرية إلى مكاسب سياسية ومعنوية: على الرغم من أن انتفاضة حماة عام 1925 قُمعت عسكرياً، إلا أن آثارها تجاوزت الخسارة التكتيكية. فقد أدت إلى تعزيز الوعي الوطني، وزيادة أعداد المتطوعين في الثورة، وتشويه سمعة فرنسا دولياً. هذا يوضح كيف يمكن للحركات الوطنية أن تحول النكسات العسكرية إلى انتصارات سياسية ومعنوية، مما يعمق الالتزام بالقضية ويحشد المزيد من الدعم الشعبي على المدى الطويل.
- الدور الحاسم للقيادة المحلية في التعبئة والاستدامة: كان وجود قادة محليين متجذرين في المجتمع الحموي، مثل فوزي القاوقجي ووجهاء عائلة البرازي ، عاملاً أساسياً في تحويل السخط العام إلى مقاومة منظمة ومستدامة. لقد تمكن هؤلاء القادة من تعبئة الموارد، وتنظيم الأنشطة السرية، وتوفير التوجيه الذي ربط تطلعات الاستقلال الوطنية بالجماهير الشعبية، مما يؤكد أهمية القيادة المحلية كجسر بين الوعي القومي والعمل الميداني.
- أهمية الوحدة والتنسيق في مواجهة سياسات التقسيم: على الرغم من محاولات الانتداب الفرنسي لتقسيم سوريا على أسس طائفية وإثنية ، فإن التنسيق العملياتي بين جبهات المقاومة المختلفة، كما يتضح من تحركات القاوقجي ، والدعوات المستمرة لوحدة البلاد السورية ، كان حاسماً في إفشال هذه السياسات. هذا يؤكد أن تماسك الحركة الوطنية وتجاوزها للانقسامات المصطنعة كانا ضروريين لاستدامة الثورة وتحقيق أهدافها النهائية في الاستقلال والوحدة.